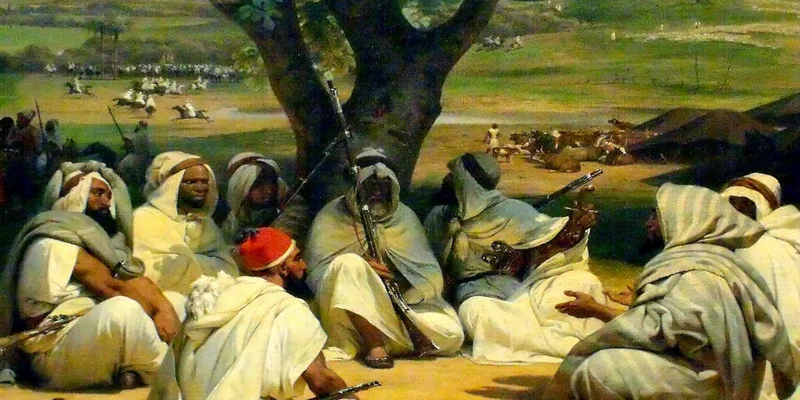ملخّص:
إنّ وقوفنا عند ملامح الألم في تجارب بعض الشّعراء الجاهليين مستند في أغلبه إلى أسباب شيوع الحسّ المأساوي في قصائدهم وطرق مقاربتهم لهذا المعنى المبثوث في ثنايا الشّعر وفي غضون الأبيات الشعريّة وقد حوّله الشّاعر الجاهلي إلى محور يستقطب مختلف الأبعاد والفنّيات التي يتمحور حوله شعر الشاعر حتى لكأنّ المنظومة القيمية نفسها يكون مبعثها غالبا إحساس الشاعر العربي القديم بالألم الناتج عن أزمة نفسية عميقة يستعرضها من خلال الطلل أو “الربع الخالي” في محاولة استكناه مغزى الوجود ومعناه في رحلة متقطّعة بين الوصل والهجر مع الأنا حينا ومع الآخر طورا آخر. ولعلّ أزمة الشاعر الجاهلي ناجمة عن في عمومها عن علاقته الحميمة بالمكان والزّمان والإنسان … وهو في كلّ بعد من هذه الأبعاد يسبر أغوار الذّات ليبحث عن راحة نفسية مفقودة. وأنّى اختلفت الأغراض الشّعرية وتباينت خصائصها الفنيّة فإنّ عاطفة الشّاعر هي العنصر الأصيل في مختلف تجاربه الشعرية التي يرسمها طريق القلق الملهم حيرة ويأسا أو ثورة وحكمة.
الكلمات المفاتيح: الأدب الجاهلي – الأمل – الألم– شعرية – البطولة.
Abstract:
We have in the old poetry blog templates with which we enlighten in this regard. However, the problem of the term remains turbulent, because not all poetic, sad experiences had sadness as a title, but in them were sorrow, worry, crying, fear and pain… And there are no linguistic patterns that reveal the connotations of pain. Thus, the style of composition expresses the crisis of ancient Arab man and his position on the universe and his fear of the unknown. Thus, the levels of expression of pain are polarized by the common semantic fields of the vocabulary of sadness and pain in their diversity and the difference in their use from one poet to another.
Accordingly, our position on the characteristics of pain in the experiences of certain pre-Islamic poets is based primarily on the causes of the prevalence of the tragic meaning in their poems and how they approach this meaning which is embedded in the folds of poetry. and in poetic verses. It is as if the value system itself often stems from the ancient Arab poet’s sense of pain resulting from a deep psychological crisis which he reviews through the ruins or the “empty quarter” in an attempt to discern the meaning of existence and its meaning in an intermittent journey between connection and abandonment with the ego at one moment and at another at another.
Perhaps the crisis of the pre-Islamic poet is caused, in general, by his intimate relationship to space, to time, to man… In each of these dimensions, he explores the depths of himself in search of a lost psychological comfort. And wherever the poetic aims differed and their artistic characteristics varied, the poet’s emotion is the original element of his various poetic experiences which he draws from the path of anxiety, confusion and despair, or revolution and wisdom
Keyword : Pre-Islamic literature – Trellis – Pain – Hope – Tournament.
1- مقدمة:
إن اصطباغ قصائد الجاهليّين بمسحة من الحزن لا يكاد يخفى وقد ألفينا ضميرا يطفح ألما لدى شعراء الجاهليّة مختلفة أسبابه ومتنوّعة تجلّياته بعد أن غلب عليهم وعي فاجع في خضمّ رحلة شاقّة ملئت قلقا ووجودا مأزوما نحو اكتشاف الآخر والموت والحياة بعد أن عجزت الذّات الجاهليّة عن الخروج من بوتقة الحيرة والألم في سبيل تأكيد إنسانيّتها والتّعبير عن جوهرها في خضمّ ذاك الجدل الأزلي بين أحلام الإنسان وطموحه في إجلاء الغموض الذي يحيط به من كلّ جانب من جهة وضعفه وتواضع قدراته وتردّيه في دائرة النسبيّة والمحدوديّة من جهة أخرى. ومن بين تلك المشكلات التي كانت تؤرّق الإنسان عموما والجاهليّ خصوصا هشاشة الحياة وفناؤها وزوالها ولا منطقيّتها على نحو ملأ حياته فراغا ووعيه شقاء فكان الألم والحزن والأسى… وكلّها سمات مميّزة للإبداع وأشعار الجاهليّين المعبّرة عن هذا المعنى من بينها.
وبناء عليه، كان الشّعر الجاهلي مسكونا بهاجس الرّحيل الذي لا يقرّ له قرار علّه يدرك دروبا يسكن إليها ويطمئنّ فيها بعد أن كانت الدّمن والأطلال مؤذنة بالخراب والموت والانتهاء. وتبعا لذلك تلوّنت قصائد الجاهليّين بالألم والتحسّر بعد أن أورثت مشاهد الطّلل والفراق في نفوسهم شجنا توضّحنا ملامحه في المقدّمة الغزليّة ورحلة الظّعن وطيف الخيال .
ويبدو أنّ الحزن في القصائد الجاهليّة لا تظهره الوقفة الطلليّة فحسب بل نلاحظ أن القلق والخوف من المجهول كامن في علاقة الجاهلي بالزّمان أيضا في اطّراد لافت للانتباه كان ليل امرئ القيس وبعض ما نقلناه عن شعراء اللّيل أحد أهمّ تجلّياته إذ انتابتهم الهموم والآلام وأرهقت نفوسهم الأوصاب ولم يكن اللّيل الطّويل لوحده بكاف لنا في إجلاء وعيهم الشقيّ بالزّمان بل كان إحساسهم به مؤرّقا لاستشعارهم الحتف في الغد أو غداة الغد وفناؤهم أفرادا وجماعات وتناهيهم. وبالتّالي فإن الموت كثيرا ما ورد مرادفا للدّهر باعتباره هادم اللّذات ومفرّق الجماعات. وكانت علاقة الجاهليّ بالإنسان سليلة هذا الوعي الفاجع الذّي يظلّ رهين الموت، فكلّ ما في الوجود إلى زوال ونهاية. فتلتقي بذلك أقانيم الزّمان والمكان والإنسان في نقطة واحدة هي الانتهاء الذي لا مفرّ منه ولا مهرب. ومن شأن هذا المصير أن يؤرّق الشاعر الجاهلي ويشغل عقله وضميره ويملأ نفسه حزنا وألما بعد أثبت الدّهر هشاشة منزلته وعبث وجوده .
وقد حاولنا أن نتنظّر مجمل هذه المعاني من زاوية نظر نحاول فيها ضبط أهمّ الموضوعات والمشكلات التي تؤلم الجاهلي وتحزنه كالوقفة الطلليّة وليل امرئ القيس والموت والرّثاء الذي غضضنا عنه الطّرف لتواتره في أبحاث الدّارسين ولتجاوزه الحقبة التّاريخية التي تهمّنا.
2- الوقفة الطللية:
تضمّنت الخطابات الغزليّة دلالات نفسيّة مكتظّة بالألم والتحسّر ولاسيّما تلك المطالع الطلليّة التي تكتمن معاني الفجيعة من الزّمن ومن انصرام الماضي الممثّل للسّعادة واللّقاء في مقابل الحاضر الشقيّ الذي انقطعت فيه حبال الوصل بين الأحبّة فأعقب في النّفس إحساسا مريرا بالفناء والموت والهلاك وأنتج وعيا متشائما من الوجود أصلا، يقول عبيد بن الأبرص في بائيّته الشّهيرة :(مخلّع البسيط)
أقفـرَ من أهلهِ مَلْحـوبُ *** فالقُطبيَّــات فالذَّنوبُ
وتعدّ القصيدة معتمد القول عند النّقاد والدّارسين في حديثهم عن الحسّ الفاجع بالزّمان عند الجاهليّين والوعي المتشائم الحزين ولذلك “قلّما أغفل دارس من المحدثين ذكرها إن تحدّث عن “الطللية” “[1]، إذ تتضمّن مشهدا من المشاهد المساوقة للموت والفناء هو مشهد الصّراع بين كاسر وثعلب تجاوزت الدّلالة فيه ما تراءى منه من معنى ظاهر إلى معنى خفيّ يتماشى مع ما قرّره الشّاعر – في مقدّماته الطللّية الكثيرة – من أجل محتوم لكلّ الأحياء “فالمنايا للنّاس بمرصد”.
ولئن خلت هذه الدّيار التي يبكيها الشّاعر من البشر وأضحت ميدانا لصراع الوحوش والكواسر، فإنّ هذه البنية قد ترمز إلى صراع الإنسان ذاته مع مناوئيه وخصومه في بيئة صحراويّة مليئة بكلّ أسباب النّزال بتقاليدها القبليّة وأحداثها التّاريخية وعاداتها الاجتماعية.
وتحفل قصائد كثير من الشعراء الجاهليّين بالرّمز الذي يكشف عن الوعي الفاجع للإنسان في حديث الطّلل الدارس، فبعد أن أقفرت الدّيار من أهلها و”طال عليها سالف الأبد” وانعدمت فيها أسباب الحياة وأضحت مرتعا للوحوش والسّباع فإذا بها “قِفارٌ مَرَوْراةٌ يَحارُ بِها القَطا” على حدّ تعبير “عميرة بن جعيل” بعد أن طمست الرّياح معالمها “وهي لبعدها يحار القطا فيها، ولذا فإنّها لغيره أشدّ حيرة لأنّ العرب تضرب المثل بها في الاهتداء”[2]. وقد تأوّل أحد الدّارسين المحدثين رمزيّة القطا في هذا الخصوص قائلا: “ولكن ما ظنّك بهذا القطا – وهو رمز الهداية – الذي يحار في هذه الدّيار؟ هل نخطئ إذا ظننّا أنّ صورة القطا ههنا رمز – وقد يكون لا شعوريّا – لإحساس الشّاعر بالحيرة في هذه الحياة؟ ولعلّ هذه الحيرة وما رافقها من مشاعر الضّياع هي التي جعلت الشّاعر يعتدّ بسلاحه الذي أعدّه لمواجهة المجهول القادم”[3].
وليس الأمر بمقتصر على البنية الشعريّة الرّامزة بل قد يشمل حديثا صريحا يتضمّن شعورا بالأسف والأسى على انصرام الماضي وحنينا إلى عهد الشباب الذّي أفل ولم يعد له من وجود إلا عن طريق الذّاكرة وفيها، وفي هذا السّياق يقول عبيد بن الأبرص في حديثه عن أطلال الدّيار:(مخلع البسيط)
وبُـدِّلَــتْ من أهْـلِـهـا وُحـوش وغـيَّـرتْ حـالَـهـا الخُطُــوب
أرضٌ تَـوارَثَـهـــا شعوب وكُـلُّ مـن حَـلَّـهــا مَـحْــروب
وتستمرّ رحلة الشّاعر في صراعه مع الموت والحياة صدى لصراع الحياة الإنسانيّة برمّتها في ميدان معركة واحد هو الكون مع اختلاف الأبطال في كلّ تجربة من تجارب الشّعراء حفاظا على البقاء ولو إلى حين. وقريبا من عبيد بن الأبرص أدرك النّابغة هو الآخر أنّ مقاومة البلى والعدم لا يتمّ إلاّ من خلال الانتصار الرّمزي له ولناقته التي شبّهها بالثّور الوحشي والقوّة والامتلاء حتى تنتصر على كلاب الصّياد التي فرضت عليه فرضا تصويرا لظلم الإنسان له. وتنتهي القصّة بانتصار رمزي للشّاعر حين يقتل الثّور أحد الكلاب وتيأس البقيّة خوفا من الهزيمة، ويرحل الشّاعر على ظهر ناقته “معادله الموضوعي” ليصرف نظره عن الخراب الذي ألحقه الدّهر بالدّيار ولا أمل له في استعادة الماضي من خلال قوله: (البسيط)
فــعَــدِّ عَــمَّــا تــرَى إذْ لا ارتِــجــاعَ لـــهُ وانْــمِ الــقُــتُـودَ عــلــى عَــيْــرانــةٍ أُجُـدِ
وفي هذا السّياق نفسه، شبّه النّابغة الذّبياني راحلته في سرعتها – في إحدى اعتذارياته- بالقطاة لتلحقه بأوّل الخيل وإن لم يكن الشّاعر معدودا من الفرسان في قومه، وقد صوّر معركة – في إطار الاستطراد – نشبت بين الصّقر وقطاته وقد نجت من قبضته لتعود إلى فرخها تطعمه. وقد ذهب الدّكتور وهب أحمد روميّة في تأويل هذه الصّورة الشعريّة إلى أنّ غرض الشّاعر لم يكن تصوير سرعة فرسه بقدر ما كان تصوير “الصّراع من أجل البقاء، فهذا الصّقر يريد قنص هذه القطاة لأنّ بقاءه مرهون بما يصيد، وهذه القطاة تجدّ في الطيران لأن حياتها وحياة فرخها مرهونتان بنجاتها”[4]. وقد عزا الباحث سرّ تعاطف “النّابغة” مع هذه القطاة وفرخها إلى أنّ “القطاة معادل شعريّ للإنسان في ضعفه وهموم حياته، وأنّ الصّقر معادل شعريّ للقوّة وجبروتها”[5].
ومهما يكن من أمر فإنّ الشّاعر الجاهلي عموما يخلع على راحلته من صفات القوّة والصّلابة والسّرعة ما يجعلها معادلا موضوعيّا له ليتحصّن بها من عوادي الدّهر وظلمه بعد أن أفسد هذه الدّيار والأطيار حين “أخنى عليها الذي أخنى على لبد” على حدّ تعبير النّابغة الذّبياني. ولذلك كان لابدّ له من سلاح ليواجهه به ويتحرّر بواسطته من هموم الدّيار. “ولذلك بدأ الشّاعر يحصّن ناقته – أو معادله الموضوعيّ- فإذا هي موثقة الخلق قويّة كأنّها العير في قوّتها، مقذوفة باللّحم قذفا، لأنيابها صريف مسموع، وهي حادّة نشيطة مسرعة وقت الهاجرة تكل المطايا وتفتر، بل هي في سرعتها في الهاجرة كثور وحشي. أمران لا يخطئهما البصر، صلابة النّاقة وسرعتها أو قل حلمه بالصّلابة وإحساسه بتغيّر الزّمن بسرعة، فكأنّه يريد أن يسابقه بهذه الناقة “[6].
ولا يقتصر الحزن في أشعار الجاهليّين على ما استعرضنا من صور شعريّة ركبنا فيها التّحليل مرّة والتّأويل أخرى سواء تعلّق الأمر بالمقدّمة الغزليّة أو قسم الرّحلة تعبيرا عن أزمة الجاهليّ في رؤيته للكون والوجود وتمثّله للموت والحياة وخوفه من المجهول وإنّما الحزن فيها مبثوث في طرائق التّعبير والتّصوير لمشاهد الظّعائن وفراق الأحبّة وبكاء الأماكن التي شهدت علاقات الوصل في الماضي. وفي هذا السّياق وقف امرؤ القيس واستوقف وبكى واستبكى حين يقول :(الطويل)
قِفا نَبكِ مِن ذِكرى حَبيبٍ وَمَنزِلِ بِسِقطِ اللِوى بَينَ الدَخولِ فَحَومَلِ
وُقوفاً بِها صَحبي عَلَيَّ مَطِيِّهُم يَقولونَ لا تَهلك أَسىً وَتَجَمَّلِ
وَإِنَّ شِفائي عَبرَةٌ مَهَراقَةٌ فَهَل عِندَ رَسمٍ دارِسٍ مِن مُعَوَّلِ؟
وقريبا من امرئ القيس هيّجت الدّمن شجون طرفة بن العبد وكانت مدعاة لاستحضار حبائل مقطوعة من الوصل والهجر وفيض من مشاعر الفقد يحاصر الشّاعر في مطالع المعلّقات أو غيرها، يقول طرفة بن العبد: (الطويل)
لـــخـــولــة أطـــــــلالٌ بـــبــرقــة ثـــهــمــد ** تـلـوح كـبـاقي الـوشـم فــي ظـاهـر اليد
وقــوفًــا بــهــا صـحـبـي عــلـي مـطـيـّهم ** يــقــولــون لا تــهــلــك أســـــىً وتــجــلـد
ويبدو الحزن والألم والتحسّر قواسم مشتركة لشعراء الجاهليّة في مطالعهم التي وقفوا من خلالها على عتبات ماض تهدّم وأعقب في نفوسهم ندامة وفي ذاكرتهم معاناة إنسانية أوجزوها في مشهد الوداع المؤلم الذي عبّر عنه خير تعبير الشّاعر الجاهلي الأعشى بقوله: (البسيط)
وَدِّع هُرَيرَةَ إِنَّ الرَكبَ مُرتَحِلُ وَهَل تُطيقُ وَداعاً أَيُّها الرَجُلُ؟
ويبدو الحسّ المأساوي لشعراء الجاهليّة في المطالع ظاهر للعيان أبرزته الأساليب الإنشائيّة المهيمنة كالأمر والنّداء والاستفهام … وغيرها كثير، أو كالوصف لهذه الأماكن التي عفّت و”أخنى عليها الذي أخنى على لبد” وقد كثرت أسماؤها وأعدادها وهو ما اعتبره أحد الدّارسين دلالة على صدق الشّعور رغم تشابه الصيغ والاستعمالات الفنّية باعتبار أنّها “أماكن وأسماء لها حضور في حياة معظم الشعراء”[7].
وحتّى وإن كان التّقليد واردا نتيجة بنية القصيدة الجاهليّة المحكمة فيبقى الحزن الحقيقي – رغم ذلك- ممثّلا في المطالع خاصّة “إذا ما عرفنا وتفهّمنا علاقة الشّاعر الحميمة في المكان الحاضن لنشأته ومشاعره وذكرياته وما انغرس في نفسه مدعاة للحزن والتأسّي”[8]. وبالتّالي لم تكن الأطلال مجرّد تقليد فنّي أو وقفة عارضة ولا يمكن أن تكون “مجرّد مشاعر فرديّة تعتمل في نفس إنسان دون آخر، وإنّما هي مشاعر مشتركة تمثّل موقفا إنسانيّا مشتركا ويتّضح ذلك في أنّ الشّاعر الجاهلي قد جمع في قطعة النّسيب التي تتصدّر قصيدته بين عنصرين: أحدهما يذكّر بالفناء في الموقف الواحد، وارتباط أحدهما بالآخر ليس إلا تأكيدا لإحساس الشّاعر بالتّناقض العامّ الماثل سواء في العالم الخارجي أو عالمه الباطني، فالتّناقض الذي تمثّله قطعة النّسيب ليس تناقضا لفظيّا أو فكريّا وإنّما هو تناقض وجودي يتمثّل في واقع الحياة كما يتمثّل في كيان الفرد الحي”[9]. حتّى أنّ عنترة بن شداد حين عجز عن تفسير هذه العاطفة المتأجّجة بين الشّاعر والمكان بعد أن رأى كثيرا ممّن خبر التّجربة وذاق مرارة الفراق والبعد فيقف إمّا متسائلا أو واصفا أو مناديا أو مترجّيا، سلك النّهج ذاته من خلال قوله: (الكامل)
هَل غادَرَ الشُعَراءُ مِن مُتَرَدَّمِ أَم هَل عَرَفتَ الدارَ بَعدَ تَوَهُّمِ؟
يا دارَ عَبلَةَ بِالجَواءِ تَكَلَّمي وَعَمي صَباحاً دارَ عَبلَةَ وَاِسلَمي
فخواء الأمكنة باعث على القلق والثّورة حينا وعلى الاعتبار والحكم حينا آخر، ألم يقل النّابغة في ما سبق: (البسيط)
فــعَــدِّ عَــمَّــا تــرَى إذْ لا ارتِــجــاعَ لـــهُ وانْــمِ الــقُــتُــودَ عــلــى عَــيْــرانــةٍ أُجُـد
إذ لا سبيل إلى استعادة الماضي، فقفر الدّيار وخرابها حقيقة ما على الجاهلي إلا الاتّعاظ منها. والملاحظ أن الأطلال تسهم في تشكيل الصّور الشعريّة للقصيدة الجاهليّة وتلقي بظلالها على تشكيل المعنى في النصّ كالظّعن وطيف الخيال، ولذلك ذهب الدّكتور مصطفى ناصف إلى أن “الأطلال أهمّ فنّ في الشّعر الجاهلي”[10].
لكلّ هذه الأسباب مجتمعة كانت الأطلال مهيّجة لشجون الشّاعر وبكائه، يقول امرؤ القيس:(الكامل)
عوجا على الطّلل المُحيل لأنّنا نبكي الدّيار كما بكى ابن خِذامِ[11]
فأزمة الجاهليّ مع المكان لا تخفى بعد أن طبعت نفسه بحزن لا ينتهي يدلّ على شدّة تعلّقه بالدّيار وبمن سكنوها ولكنّهم رحلوا عنها وعفّت الأمكنة ودرست وأصابها تغيير شامل أحسّ من خلاله الجاهلي أنّ الزّمان الذّي أفناها حتما سيفنيه هو الآخر حيث “أجال الإنسان نظره فيما حوله، فلم يلبث من أنّ كلّ ما في الوجود هو مثله فريسة، للتّغيير والصّيرورة والتّناهي والفناء”[12]. وهو إحساس يكون في حاضر الزّمان ويمثّل نتيجة ما خبره الشّاعر في حلّه وترحاله بعد ما ضرب في الأرض وجاب الأفاق وعلّمته الأطلال درسا قاسيا في الانتهاء والزّوال وقد شهد خراب القفار وموت الأحياء. يقول عمرو بن قميئة في هذا الصدد:(الطويل)
أمِنْ طَلَل قَفْرٍ ومن منزلٍ عافِ عفتهُ رياحٌ مِنْ مشاتٍ وأصيافِ
بكيتَ وأنت ـ اليومَ ـ شيخ مُجرب على رأسهِ شرخانِ من لونِ أصنافِ[13]
إنّ هذا الموقف يتّضح في ما استشعره بشر بن أبي خازم حين رأى في الأطلال رمزا لانقضاء الحياة وحلول الفناء بدلها، فقال: (الكامل)
أَطلالُ مَيَّةَ بِالتِلاعِ فَمِثقَبِ أَضحَت خَلاءً كَاِطِّرادِ المُذهَبِ
ذَهَبَ الأُلى كانوا بِهِنَّ فَعادَني أَشجانُ نَصبٍ لِلظَّعائِنِ مُنصِبِ[14]
وقريبا منه قول امرئ القيس: (الطويل)
دِيارٌ لِهِندٍ وَالرَبابِ وَفَرتَنا لَيالِيَنا بِالنَعفِ مِن بَدَلانِ
لَيالِيَ يَدعوني الهَوى فَأُجيبهُ وَأَعيُنُ مَن أَهوى إِلَيَّ رَوان
ويتّضح ممّا تقدّم أن بكاء هؤلاء الشّعراء على الأطلال هو في حقيقته بكاء على انصرام عهد الشّباب واللّقاء بالأحبّة وعلى ذهاب الماضي الذّي لم يبق منه إلا الذّكرى والحنين إليه. وبذلك يتوقّف الزّمن الحاضر ويلتفت الشّاعر إلى زمن الأطلال “والوقوف عندها اجترار للذّكريات وحركة توقّف عن الحاضر لتنطلق منه إلى الماضي تعيد تشكيله في العمل الفنّي تشكيلا يمتلك هذا الماضي ويسيطر عليه للتخلّص من سيطرة ذلك الماضي على الذّات وامتلاكه لها”[15]. بل حتّى أكثر من ذلك ذهب أحد الدّارسين القدامى إلى أنّ الشّاعر الجاهلي لا يبكي ماضيه بقدر ما يبكي مستقبله “الذي ينشدّ إلى نقطة سبقت الحاضر وامتدّت عبره إلى المستقبل”[16].
ويبدو من امتزاج المكان والزّمان في مخيّلة الجاهلي أنّ مواجهة الوجود عنده ليست بكاء على الماضي انطلاقا من الحاضر فحسب وإنّما من خلال المستقبل أيضا الذي يلقي بظلاله على تصوّر الإنسان للكون والحياة و الفناء والموت والمصير … ولأجل كلّ ذلك كان الشّاعر الجاهلي يستبطن في أشعاره لتلك الغربة العميقة التي تعتمل بداخله وهو الذّي يعيش على إيقاع التبدّل والتّغيير في قلق أمام غموض الحياة، وحيرة أمام الخطر الذي يتهدّد لحظة السّعادة والاستقرار دائما بالبين والرّحيل.
والمستخلص لدينا مما تقدّم أنّ الشاعر الجاهلي في وقوفه على الأطلال يخوض تجربة دراميّة في معناها الواسع إذ يعيش على إيقاع شعورين متناقضين هما الحزن والفرح أو الألم والسّعادة أو الهجر والوصل… وغيرها كثير لاسيّما وأنّ الجاهلي يستحضر ذكرى حبّ حبيبة ظعنت في المكان ولم تخلّف وراءها إلاّ ذكريات أليمة علقت بمخيلة الشّاعر يستعيدها في زمن الحاضر الذي يجسّد زمن الشّقاء المعيش في مقابل زمن الماضي السّعيد الملهم الذّي يحضر بالقوّة في وجدان الجاهلي علّه يعوّضه عن حسّه الفاجع بتناقضات الوجود بعضا من طمأنينة مفقودة افترض وجودها حين أيقن بأن لا شيء يدوم، وإنّما الفناء هو القانون المتحكّم في بناء حركة المعنى في الشّعر وفي الواقع نفسه. ولأجل ذلك، كان حزن الشّعراء الجاهلييّن كبيرا وكان وقعه مأساويّا لم تكن الأطلال الدّارسة – لوحدها- بكاشفة عنه وإنّما وقفت إلى جانبها موضوعات أخرى لم تقلّ عنها أهميّة أوضحها شعراء اللّيل وامرؤ القيس من أبرزهم .
3- شعرية الليل عند امرئ القيس:
يمثّل اللّيل وجها من وجوه التّعبير عن الزّمان تناوله الدّارسون في هذا الإطار باعتباره قطعة من الزّمن الطّبيعي أو النّفسي لاسيّما وأنّ كلمة الزّمان أو مرادفها الزّمن لم تردا في القرآن الكريم كما خلت منهما السّبع الطوال ومعلّقة امرئ القيس من بينها. وقد خصّ هذا الشّاعر اللّيل بوقفة خاصّة اتّسمت بشمول النظرة إلى التّركيز على شعريّته[17]. كما أنّ قصيدة امرئ القيس لم ترد بها كلمة الزّمان وغابت عنها أيضا سائر أسمائه المتعلّقة به، ودلّ على حضورها فيها أسلوبه الشعريّ أو ما اتّصل منها باللّحظات المأثورة لدى الشّاعر المندرجة في زمن الذّكريات. على أنّ طرائق تقدير الزّمان وكلّ أسمائه قد جرت في سائر شعره في ديوانه[18].
ومن بين الأوقات الكثيرة المذكورة في الشّعر الجاهلي خصّ الشّاعر حديث اللّيل بالوصف تصويرا وتمثيلا حسيّا وإن لم يخل من الرّمز المحيل على موقف من الزّمان يقفه الجاهلي منه وعلى رؤية منها إليه ينظر، هذا فضلا عن مقصد فنّي يظهر تفنّنا بلاغيّا وتصويرا تعبيريّا استحسنه النقّاد القدامى لجودته وإصابته الصّفة على حدّ تعبيرهم . وقد حضر في مطوّلة امرئ القيس – التي توفّرت على ذكر اللّيل ذكرا صريحا مباشرا كان فيه الزّمن المذكور موضوعا للقول – زمنا اللّيل والنّهار باعتبارهما وقتين متضادّين.
وقد اعتبر ليل امرئ القيس أهمّ تجلّ من تجلّيات حضور الزّمان في المعلّقة، امتاز بالطّول والهمّ وشدّة الظّلمة في وصفه الذي كان تجسيما وتجسيدا لـ “حيوان ضخم يتمطىّ بصلبه وينهض متثاقلا بمقدّمة جسمه كما لو كان جملا يطحن بكلكله من تمكّن منه فخاطبته الذّات الشّاعرة مهيبة به أن ينجلي بصبح، ولكنّها كانت وهي تخاطبه مهمومة إذ لم تر في الصّبح المنتظر ما يجلي من همومها وما يبدّل أو صابها راحة”[19]. لقد كان الظلام عليها مطبقا كموج بحر “وبدا اللّيل ذا قصد و نيّة إذ حشد الهموم ليبتلي ذات المتكلم وتجسّمت نيته في ابتلائها بالتجسّد”[20]. وقد تجاوز الشّاعر في وصفه اللّيل الحزن والألم إلى معنى المعاناة والابتلاء بالهموم التي أقضّت مضجعه وأرّقته وهو المحتاج إلى النّوم والرّاحة فيخاطبه ويحاوره في قلق ويأس قائلا في شأنه: (الطويل)
وليل كموج البحر أرخى سدوله عليّ بأنواع الهمــــوم ليبتــــل
فقلـــت لما تمطـــى بصلبــــــه وأردف أعجازا ونــــاء بكلكــــل
ألا أيها الليل الطويل ألا أنجــــل بصبح وما الإصباح منك بأمثل
وقد أكّد الشّاعر على طول ليله المرفوق بالهجر والأوصاب قائلا: (المتقارب)
تَطاوَلَ لَيلكَ بِالأثمدِ وَنامَ الخَلِيّ وَلَم تَرقُدِ[21]
واشتدّ سواد لونه حتىّ كاد يطبق على قصيدته المطوّلة من مبتدئها إلى منتهاها اشتدادا أدعى إلى إثارة هواجس الشّاعر وتهييج أحزانه وبلابله على حدّ تعبيره هو نفسه. ذلك أنّ ارتيابه من الزّمان وغموض غده ومستقبله جعلا للّيل هذه الصّورة المضطربة اضطراب أمواج البحر المحيلة على انطباق آفاق الحياة عليه وارتيابه من المجهول. ولكلّ هذه الأسباب مجتمعة وفي نفس السّياق من تصوير اللّيل تجسيدا وصف جواده قائما بين يدي صاحبه ليلا مسرجا “كأنّ راكبه ليس يدري متى يهبّ من نومه مذعورا ليثب على صهوته”[22]. وهذه الرّؤية الشّعرية التي يصدر عنها الشّاعر تعكس خوفه من الزّمان وموقفه من الوجود وإن اختلفت التّجارب الشّعرية ومنطلقات أصحابها، إلاّ أنّ الثّابت لدينا أن “الخوف من الزّمن ومن الشرّ الذي يدخل في نسيجه وحركيّته قد تأصّل في نفس الإنسان الجاهلي بصورة واضحة”[23]. وهو معنى متواتر في قصائد جاهليّة عديدة حتىّ لكأنّها تعكس همّا مشتركا ومصيرا أوحد من الموت والحياة والوجود والكون… يقول النّابغة الذّبياني بخصوص تطاول اللّيل عليه وابتلائه بأنواع الهموم قولا مشابها لسلفه امرئ القيس الذّي تقرّ الدّراسات بأسبقيّته لكلّ الشّعراء في تقصيد القصائد، وقد استطال ليله واكتظّ بوعي فاجع وحسّ مأساوي لا يكاد يخفي، يقول: (الطويل)
كِليني لِهَمٍّ يا أُمَيمَةَ ناصِبِ وَلَيلٍ أُقاسيهِ بَطيءِ الكَواكِبِ
تَطاوَلَ حَتّى قُلتُ لَيسَ بِمُنقَضٍ وَلَيسَ الَّذي يَرعى النُجومَ بِآيبِ
وَصَدرٍ أَراحَ اللَيلُ عازِب هَمِّهِ تَضاعَفَ فيهِ الحُزنُ مِن كُلِّ جانِبِ[24]
ويبدو من هذا الوصف أن الناّبغة قد سلك المسلك ذاته فتطاول ليله هو أيضا ونشأت معه ناشئة الأوصاب والهموم ومعها توتّرت نفس الشّاعر والقارئ من ورائه إشفاقا ومؤازرة علّه يمثل نداء الاستغاثة تفريجا للكرب وإزاحة للهمّ إن لم يكن بالفعل فبالشّعور المشطور بين المخاطِب والمخاطَب المفرد بصيغة الجمع.
وإذا ما التمسنا بعض الأسباب التي أحزنت الشاعر الجاهليّ – فضلا عمّا ذكرنا في مواطن سابقة أجملناها في سطوة الزّمان الغادر وغموض تصاريفه أو في ما لم نذكر من قبيل اتّصال المدّة بالماضي العاطفي السّعيد الذّي يحضر تذكّرا هو بعلوق أسباب الهوى أدعى فيحمل الذّات الشّاعرة على الانفعال الوجداني شوقا وحنينا إلى ما مضى من زمان الوصل والبهجة “ويعزّ على المتذكّر استرجاعه إلاّ وهما”[25] ألفيناها في ما أهمّ امرأ القيس من “أمر” بعد صحوته من “خمر” وقد ركب من الغايات العظام ما يتعب ويشقي لإدراك المطالب “وإن عصفت به الوساوس والمخاوف فإنّما هو يحاول مجدا مؤثلا وحقّ لمن كان مثله أن يدركه، وهو يحاول ملكا أو يموت من دونه وهو خلال ذلك يحلم – افتراضا على الأقل- بأن يرجع إلى بلاد الروم وقد أدرك بغيته: (الطويل)
وَإِنّي زَعيمٌ إِن رَجِعتُ مُمَلَّكا بِسَيرٍ تَرى مِنهُ الفُرانِقَ أَزوَرا”[26]
وتبدو شكوى امرئ القيس من طول اللّيل موصولة بما يرمز إليه قوله: (البسيط)
يا صاحبي إذا خفتما غرضي فعلّلاني فانّ اللّيل قد طالا[27]
وهو قول يستبطن دلالة على “أن اللّيل الذي طال قد يكون رمزا إلى الانتقال بين الأحياء وما يلابسه من شعور بالغمّ والحزن من سوء معاملة – كطمع عامر بن جؤين الطائفية – وقد يكون رمزا إلى حال الضّياع التي صار إليها الملك الشّاعر”[28]. ولئن طال ليل امرئ القيس وابتلاه بالأوصاب وناشئة الهموم، فإنّ من الدّارسين من رأى في وصف الحصان وحركته تحقيقا لوظيفة “معارضة الليل الذي يتّسم بالثّقل والثّبات والتّجمّد وبذلك يعارض امرؤ القيس –على رأي مصطفى ناصف- اللّيل بالفرس. وقد وصف الفرس في موضع آخر بأنه “البطل” “[29]. على أنّ هذا “الوصف” “الحُرُك” للّيل قد تقف إلى جانبه قتامة لونه واشتداد سواده الذّي يمكّن من إبراز نقيضه ممثلا في بياض الحبيبة أو وميض البرق، وهو حضور للعبة الألوان مهمّ لأنه يسهم في إيضاح ما تكتمنه الرّموز من دلالات ومعان تنزل منازلها بيانا لمقاصد الشّعر وغايات الذات الشّاعرة. وإن حمل البرق على معنى الأمل، فإنّ من الدّارسين من رأى فيه دلالة على ما يعتمل في نفس الشّاعر من “حيرة وخوف مما يخبؤه الغد وإلى ما يثور فيها من شجون وحزن على “أهله الصالحين” وعلى ضيعتهم وتقتيلهم جماعات بدليل أرقه يراقب البرق الوامض في ليل يتطاول ما يتطاول وتنشأ معه ناشئة الهموم والأوصاب ولا نحسب ذلك لقلق غامض يعتريه وإنما لما آلت إليه حاله من ضياع ملك ومن تحديد غاية في حياته مضبوطة واضحة وهي استعادته لهذا الملك بالسّعي الحثيث الذّي لا ينقطع بين الأحياء والقبائل ولدى ملوك غسان وقيصر الرّوم”[30].
وبالتّالي، لم يكن الإحساس بالزّمان وحده الفاجع وإن صوّر الشّاعر اللّيل في صورة المفترس والموج والبحر والنّجوم التي تأبى الأفول. فالملاحظ أنّ هموم الجاهلي متنوّعة أسبابها مختلفة وجوهها حاولنا حصرها في ما ذكرنا أو في ما عانى منه بعض الشّعراء من مصيبة الموت والفقد أجلاها قول أحدهم في رثاء ابنه: (الوافر)
أُرِقت فبتُّ لم أذق المناما وليلي لا أُحسن له انصراما[31]
وليس لفقد الأبناء فقط يبكي الشّاعر وإنّما أيضا لرحيل الأحبّة تسيطر عليه الهموم في اللّيل وتجتمع، فيصيبه الكرى والأرق وناشئة الهموم والأحزان، يقول أسامة بن الحارث في هذا الصدد: (الطويل)
أَجارَتَنا هَل لَيلُ ذي الهم راقِدُ أ َمِ النَومُ عني مانع ما أُراوِدُ
أَجارَتَنا إِنَّ اِمرَأ لَيَعودُهُ مِن أَيسَرِ مما بِتُّ أُخفي العَوائِدُ
تَذَكَّرتُ إِخواني فَبِتُّ مُسَهَّداً كَما ذَكَرَت بَوّاً مِنَ اللَيلِ فاقِدُ[32]
كما يشكّل الخوف من الممدوح وفراق المرأة أحد أهمّ أسباب الغمّ والهمّ عند الشّاعر الجاهلي، ذلك أنّ غضب وليّ نعمته وهجر حبيبته “يسلمان الشّاعر إلى الزّمن ويتركانه في مواجهته مجردا من وسائل المواجهة التي رآها أحيانا في المرأة والممدوح، ولذلك فانّ الشّاعر يأرق ليلا، بسبب الزّمن، كما يأرق إذا وجد أن وسائل المواجهة في حالة غياب”[33]. وفي سياق متّصل في ذكر أسباب أحزان الجاهليّ في علاقتها باللّيل، يقول النّابغة الذّبياني مشبّها غضب ممدوحه بما استقرّ في وعيه من قسوة إذا رهب ومن قوّة إذا رغب: (الطويل)
فإنّك كاللّيل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع[34]
والملاحظ أن ليل الأسى والهموم لا ينجلي، فيتطاول تطاولا دلّت عليه حركة النّجوم الثّابتة حتىّ لكأنّها ربطت بحبال غليظة شديدة الفتل ووثقت بصخور ضخمة، وهو وصف غير مباشر دلّ عليه قول امرئ القيس: (الطويل)
فيا لك من ليل كأنّ نجومَه بكل مُغار الفَتلِ شُدّتْ بيَذْبُل
كأنّ الثريّا علّقت في مَصامها بأمراس كّتّان إلى صًمّ جندَلِ[35]
وهو ثبات للنّجم يعكس حالة الشّاعر النّفسيّة وقد ملئت نفسه ألما ويأسا وانتابته الهموم والأوصاب في ليل لم يشأ أن يتزحزح فأورث في صدر الشّاعر انقباضا وحزنا، وحتّى متى انجلى اللّيل وسواده فإنّ النّهار لم يكن بأحسن منه حالا، وإنّما ماثله في طوله وهمه “وما الإصباح فيك بأمثل”، وكأنّنا بالشّاعر مطارد في الزّمنين (اللّيل والنّهار)، لا يقرّ له قرار في أيّ منهما، وهو ما لم يستحسنه العسكري وأدخله في باب الغلوّ.
إنّ ما ذكر من أمر اللّيل في كونه لا يختلف عن النّهار يعكس فاجعة الإنسان الجاهليّ من الزّمن إذ هو واقع بين فكّيه ولا مهرب له منه ليلا أو نهارا. وإذا لم ير الشّاعر في انجلاء الظّلمة وقدوم الصّبح المنتظر تبديدا للهموم وتبديلا للحال، فإنّ في ذلك تشاؤما من الحياة في بعد وجودي يقدّر الزّمن ويقيسه بالإحساس والشّعور أكثر من تحقيب وتقسيم إلى ساعات ودقائق تعدّ وتحسب، ولأجل ذلك كان اللّيل البهيم بظلمته الدّاجية مساوقا لنور الفجر ووضح النّهار دالاّ عليه في سرمديّة لا نهاية لها في علاقة بمعنى الوحدة والانفراد والوحشة التي توحي بها صورة السّتائر المسدلة “فهل نستنكر على من كان يشعر بهذه المشاعر القاتمة أن يبكي، وأن يستوقف الآخرين ويستبكيهم على هذا المصير الإنساني الفاجع؟ إنّه الشّاعر البصير الذي يرى ويدرك ويحسّ ما لا يراه الآخرون ولا يدركونه ولا يحسّونه، أفلا يجب عليه أن يستوقفهم ليتأمّلوا حقيقة “الوجود الإنساني” ويبكوا عليه …؟”[36].
إنّها غربة الوحدة في وحشة اللّيل ذكّرت بما قاله النّابغة الذّبياني في السّياق ذاته: (الطويل)
كليني لهمّ يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب
إنّها رغبة في الانفراد بالذّات والبقاء في وحدة هموم ليل طويل وأحزانه أبى ألاّ ينجلي ونجومه ألاّ تأفل، فكان الأسلوب الإنشائي ممثّلا في الأمر للاختلاء بالذّات في وحدتها تتدبّر أسرار الكون وتتأمّل بعمق المصير والوجود الإنسانيين بعد أن عرف الشّاعر أن لا فائدة ترجى من البكاء على أطلال الماضي، ألم يقل النّابغة نفسه “فعدّ عمّا ترى إذ لا ارتجاع له”؟ ورغم ذلك فإنّنا نستشعر تشاؤما لذات مكلومة يحيط بها الفناء والعفاء من كلّ جانب.
ولئن استجاد النقّاد القدامى فصاحة امرئ القيس وبراعته في التّصوير إلا أنهم استهجنوا تعبيره الذّي خالف فيه العادة إذ خرج عنها ليدخل بابا مستكرها فيه “بعض العيب” “لأنّه جعل اللّيل والنّهار سواء عليه فيما يكابد من الوجد والحزن وجعل النّهار لا ينقصه شيء من ذلك. وهذا خلاف العادة “الذي أدخله” في باب الغلو”[37].
وإذا كان النّاقد قد استجاد وصف امرئ القيس للّيل حين سلك طريق التّجسيد والتّجسيم باعتبارهما “أساس الشّعر” و”قوام الشّعرية” في نظر النّقد العربي القديم فإنّه كره خروجه عن المألوف والعادة. وكان الشّاعر قد أصاب الصّفة وأحسن التّشبيه ففضّل النّقاد أسلوبه الشّعري في وصفه الزّمن وقد تدرّج فيه من “شمول النّظرة إلى التّركيز على “شعريّة” اللّيل” عمّن سواه من شعراء اللّيل. وقد أثبت الشّاعر أفضليته على الطرمّاح رغم إصابته المعنى “إلاّ أن لفظه لا يقع مع لفظ امرئ القيس والتكلّف في قوله –بطرحيهما طرفيهما – كلّ مطرح بيّن والكراهية فيه ظاهرة”[38].
وقد اعتدّ الشّعر والنّقد الأدبيان القديمان بأبيات امرئ القيس في وصف اللّيل باعتبارهما مثالا في إحسان التّشبيه وإصابة الصّفة مثلما ذكرنا في مواضع سابقة من البحث. ولم يكن الطرمّاح الوحيد الذي اقتفى أثره وإنّما استرفد النّابغة الذّبياني بشعر امرئ القيس استرفادا أشبهه فيه من جهة المراوحة بين النّور والظّلمة أو البياض و السّواد حين يقول : (الطويل)
أصاح ترى برقا أريك وميضه يضيء سناه عن ركام منضد
ولئن كنّى عن اللّيل بذكر بعض متعلّقاته (البرق) فإنّ ذلك لم يمنعه من تغليبه في أشعاره غلبة لافتة للانتباه ولاسيّما في مقدّمته البائيّة في مدح عمرو بن الحارث الذي التحق به هاربا من النّعمان الثالث بسبب وشاية به إليه في شأن المتجرّدة، فقال: (الطويل)
كِليني لِهَمٍّ يا أُمَيمَةَ ناصِبِ وَلَيلٍ أُقاسيهِ بَطيءِ الكَواكِبِ
تَطاوَلَ حَتّى قُلتُ لَيسَ بِمُنقَض وَلَيسَ الَّذي يَرعى النُجومَ بِآيبِ
وَصَدرٍ أَراحَ اللَيلُ عازِب هَمِّه تَضاعَفَ فيهِ الحُزنُ مِن كُلِّ جانِبِ
كما ذكر اللّيل في عيّنية أخرى شهيرة للنّابغة الذّبياني في اعتذاره إلى النّعمان يقول فيها: ( الطويل)
فبتُّ كأني ساورتني ضئيلة من الرُّقْشِ، في أنيابِها السُّمُّ ناقِع
يُسَهَّدُ، من لَيلِ التّمامِ، سَليمُها، لحليِ النساءِ ، في يديهِ ، قعاقعُ
تناذرَها الرّاقُون مِنْ سمعها، تُطلّقُهُ طَورا، وطَوراً تُراجِعُ[39]
ولم نعدم حضور الزّمن المذكور (اللّيل) في ما قاله في مرض النعمان: (الطويل)
كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا وهمين هما مستكنا وظاهرا [40]
ويبدو ممّا ذكرنا في شواهد متقدّمة – وممّا لم نذكر- أنّ ليالي النّابغة قد كانت مكتظّة بالهموم والأحزان والأوصاب فيما كان النّهار موصولا بالوقوف على الأطلال ومساءلتها .
ولعلّنا نلمس في ما استحضرناه من شواهد دالّة على سياقات ورود اللّيل بعض الأسباب التي أقضّت مضجع النّابغة وأرّقته في ليل طويل مليء بالرّهبة والمخاوف شغل القدامى فتمثّلوا به لاشتهاره وذيوع صيته تصويرا وتعبيرا. وفي هذا الإطار يطالعنا اللّيل الخائف صاحبه من فاقة وحاجة عبّر عنه من خلال قوله: (الطويل)
فسر في بلاد الله و التمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا
وما طلب الحاجات في كل وجهة وكيف ينام الليل من بات معسرا؟[41]
ولئن كان ورود اللّيل في هذه السّياقات طبيعيّا إن تلميحا أو تصريحا وارتبطت معانيه فيها بناشئة الهموم والأحزان والآلام، فإنّ له استعمالات أخرى تلبّس فيها بإحساس الشّاعر العميق بظلم الزّمان للإنسان في انصرامه وتولّيه معبّرا عن فنائه مهما طال به الأمد. على أنّنا نلاحظ أن هذه الاستعمالات للزّمن ومراوحة النّابغة بين البياض والسّواد قد أشبه فيهما شعر امرئ القيس الذّي عرّف فيه اللّيل والنّهار باعتبارهما “الحدثان” و “الجديدان” تأكيدا على جدّة الزّمان في مقابل تقادم الإنسان وتآكله وتناهيه بمجرّد ولادته لاسيّما “أنّ كل يوم يمرّ من حياته يمثّل قربا من نهايته”[42]. فالزّمان أبدا جديد وهو في حركة قدوم مستمرة لا يدركه البلى والزّوال بينما النّاس هم الفانون، يقول ذو الأصبع العدواني تأكيدا لهذا المعنى:
أهلكنا اللّيل والنّهار معا والدّهر يغدو مصمّما جذعا[43].
ولعلّ هذا الوعي بالفناء قد جعل الشّعراء الجاهليّين ينظرون للموت في علاقته بالزّمن نظرة مخصوصة شكّلت محورا من محاور اهتماماتهم الوجوديّة ومشكلاتهم الأساسيّة نروم النّظر فيه من خلال ما يلي:
4- تجربة الشّعر الجاهلي في مواجهة الزّمان:
لقد حفل النصّ الشّعري القديم بانشغال الجاهلي بمقولة الزّمن على مساحة واسعة من اهتماماته، وقد ارتبط لديه بحسّ مأساوي لا يخفى وفجيعة كامنة في الوعي الفردي والجماعي للشّعراء الجاهليّين على حدّ السّواء. وإذا ما كان امرؤ القيس قد عدّ من الأوائل في قول الشّعر بحسب تصنيفات النّقاد والدّارسين، فكان سبقه لغيره حافزا لمن أتى بعده في ترسّم الشّعرية، إلاّ أنّه في موضوع الزّمان قدّم عليه القدامى ممّن ارتأوا أنّهم سبقوه إلى طرق المعنى، وهو تراتب لا يخضع للسنّ بقدر ما كان يستجيب لفكرة “الأوائل” “ولعلّهم لهذا السّبب بالذّات قدّموا امرأ القيس باعتباره أوّل من وقف على الطّلول واستوقف وبكى واستبكى وشبّه الخيل بالعقبان والعصيّ كما اعتبروا عمرا بن قميئة أوّل من بكى الشّباب ونحوه من ولعهم بالأوائل في كلّ شيء”[44]. وتبعا لذلك، صنّف الشّعراء بحسب ما هيمن على كلّ طائفة منهم من تخصّص في مذاهب الفنّ وقول الشّعر من قبيل “اختصاص بعض الشّعراء باللّيل واختصاص البعض الآخر بالموت وتناهي الإنسان وهشاشة مصيره ممّا يحملنا على اعتبار نوع وعيهم بالزّمان وعيا فاجعا متشائما واختصاص طائفة ثالثة بالسّعي إلى تجاوز الفناء والتّناهي عن طريق الفعل البطولي …”[45].
وقد يكون من المفيد أن ننظر في ما أرّق الجاهلي في مسألة الزّمن وارتباطها بالموت بعد أن تلبّست المفاهيم بما يحيل عليها من قبيل الدّهر من حسّ مأساوي فاجع أعجز الجاهليّين عن فهم أسراره وفكّ غموضه، إذ ظلّ الموت بالنّسبة إليهم ممثلا في سلطان الزّمان على الإنسان وإن كان معلوما إلاّ أنّه بعيد رغم قربه ملغز رغم معرفته. ولأجل ذلك، كان الشّاعر الجاهليّ قلقا مأزوم الوجود فصوّر الموت بما يدلّ على ألمه وخوفه منه تجسيدا مرة وتجريدا أخرى في شقاء للوعي لا يخفى. فكانت معاني رثاء الإنسان مبثوثة في تضاعيف أشعار الجاهليّين لا نسمع فيها إلاّ أنة “الفقد الشّامل، والجزع المقيم، والإحساس بأن الحياة عبث ولهو وباطل وقبض ريح”[46]. وقد نفسّر فجيعة الجاهليّ وحساسيته المفرطة تجاه أمر الموت والزّمان والدّهر بما كان يفتقده من وازع ديني يهدّئ من روعه ويطمئنه ببرد اليقين حول الموت والفناء والبعث والحساب والجزاء … لأجل كلّ ذلك اضطربت نفسه وعجز عن التحرّر من المأساة فأنتجت ألما وحزنا كبيرين.
وفي هذا السّياق ذاته من محاولة النّظر في تجارب الشّعراء الجاهليّين الشّعرية وهم يواجهون الزّمن يستوقفنا ما خصّ به أحد الدّارسين المحدثين من حاول البحث عن تجلّيات “الوجوديّة الجاهليّة” في غير أشعار طرفة بن العبد من نقد صريح باعتبار أن الشّاعر المذكور قد كان وعيه بالزّمان حادّا واستشعاره للموت فاجعا، وذلك بقوله: “ولعلّ من انكبّ منهم على التماس “الوجودية في الجاهليّة” اعتمادا (…) على شواهد منتقاة انتزعت من سياقها من شعر عمرو بن كلثوم وشعر المرقّش الأكبر وشعر يزيد بن حذاق كان يغنم أكثر لو تدبّر شعر طرفة لما يتوفّر عليه من إرهاص بأن يعتبط شابّا ومن استشعار للحتف في غد ومن تسارع وحدة في لهجة الخطاب”[47]. على أنّنا لا نعدم هذا الزّمان القلق والمتوتّر عند عدد من الشّعراء الجاهليّين الآخرين كلبيد بن ربيعة وعدي بن زيد وبشر بن أبي حازم وامرئ القيس وعبيد بن الأبرص الذي رأى الباحث نفسه في أشعاره قنوطا من العيش ووعيا متشائما[48].
وتعدّ قصيدة طرفة بن العبد “من أوثق السّبع الجاهليّات صلة بالزّمان”[49]. إذ يتجلىّ البعد الوجودي للزّمان عنده في ما تأكّد لديه من وعي فاجع للأجل المحتوم وهو يحاول سبقه بما ملكت اليد علّه يروي ظمأه قبل فوات الأوان وإدراك الموت له وفي نفس الفتى وعي مستقرّ بضرورة مواجهة المنيّة والانتصار عليها بالمغنم من دنيا فانية فيصيب منها ما يجعله يحسّ بسبقه للزّمان والإفلات من قبضته. وقد يحتدّ وقع الخوف والشّقاء في نفس الجاهليّ حين يحسّ يتآكل العمر وتناقص الأيام بفعل مرور الزّمن وانقضاء الدّهر. وهو إحساس ذو بعد وجودي يرتبط فيه الموت بسلطان الزّمان ارتباطا وثيقا، يقول طرفة بن العبد تأكيدا لهذا المعنى: (الطويل)
صباح الفتى ينعى إليه شبابه ** وما زال ينعاه إليه مساؤه
ويبكي على الموتى ويترك نفسه ** ويزعم أن قد قل عنهم عناؤه
ولو كان ذا عقل وحرم لنفسه ** لطال بلا شك عليها بكاؤه[50].
والمعنى الذّي تتضمّنه الأبيات الشعريّة المذكورة متردّد صداه في أشعار جاهليّين آخرين أيضا عظم عندهم الإحساس بالموت لحظة ذكر الزّمن وهما يسيران في اتجاهين متضادّين، فكلّما مرّت المدّة الزمنيّة إلاّ واقترب الإنسان من نهايته “ومن هنا أصبح لمشكلة الزّمان صفة الإشكاليّة، فكلّ امتلاك يمثّل بالنّسبة للإنسان زيادة، ما عدا امتلاك الزّمن الذّي يمثّل فقدا”[51]. وبالتّالي أدرك الجاهليّ أنّ الوجود الزّماني مقرون بالفناء والشقاء، إذ “أنّ كل يوم يمرّ من حياته يمثّل قربا من نهايته”[52]. يقول حاتم الطّائي تأكيدا لهذا المعنى: (البسيط)
يسعى الفتى وحمام الموت يدركه وكلّ يوم يدني للفتى الأجل[53]
وهو قانون جماعي يؤكّد حقيقة موت الإنسان وتناهيه في بعد شمولي لا يستثني أحدا من الوقوع في “حدثان الدهر” الذّي طالما ارتبط بالفناء في ذهن الجاهليّ، يقول زهير بن أبي سلمى: (الطويل)
ومن هاب أسباب المنايا يلقها ولو رام أسباب السّماء بسلّم
ويقول أيضا: (الطويل)
فبدا لي أن النّاس تفني نفوسهم وأموالهم ولا أرى الدّهر فانيا[54]
وفي إطار محاولتنا استجلاء البعد الوجوديّ للزّمان عند طرفة بن العبد – الذّي خلت معلّقته من الكلمة (الزّمان) ما عدا أسماءها أو ما دلّ عليها فمتواتر فيها – نروم الوقوف عند فلسفته في مواجهة الزّمان الفاجع وقد طالعتنا في مبادرته للمنيّة بما يملك ملكا ماديّا ومعنويّا علّه يستبق الأجل المحتوم فيكون المغنم تروية ذاته العطشى قبل أن يدكها الموت بــ “ثلاث هنّ من عيشة الفتى”، يقول طرفة بن العبد في هذا السّياق مخاطبا لائمه: (الطويل)
وإن كنت لا تسطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدّك لم أحفل متى قام عوّدي
فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبد
وكرّي إذا نادى المضاف محنّبا كسيد الغضا نبهته المتورّد
وتقصير يوم الدّجن والدّجن معجب ببهكنةٍ تحت الخباء المعمّد[55]
إنّ هذا المذهب الذّي للشّاعر في محاولة انتصاره على الزّمان من خلال ما أتى به من مبادرة الدّهر تندرج في إطار الإغراق في اللّذة الحسيّة بمبادرة المنيّة بما يملك سواء تعلّق الأمر بملك ماديّ الطّارف منه والتّالد أو ملك معنوي مجسّم في مفهوم البذل زمني السّلم والحرب. على أنّ البعد الوجوديّ – في الشّاهد المتقدّم- قد داخله بعد آخر نفسيّ . ويبدو أن هذا الإغراق في اللّهو والارتواء من ملذّات الحياة قد كان درءا لسوء المصير والفناء واستحالة الخلود وهروبا من الشّقاء والأجل المحتوم الذّي كتب عليه فجعل العمر كنزا ينقص كلّ ليلة. ولأجل كلّ ذلك اقتنع الشّاعر الجاهليّ بضرورة الارتواء بشربة من ماء الحياة وإن أعقبها ظمأ الاضمحلال لا محالة. ويبدو أنّ اقتناص لذّة العيش هذه قد كانت نتاج تأمّل الشّاعر في الكون والمصير فتأسّست بذلك فلسفته – على غرار غيره من الشّعراء- على موقف وجوديّ أساسه اللّذة “خوفا من ضياعها، ويأسا من دوامها، فلعلّ في تحقيق اللّذة انتصارا على الموت، ذلك أنّه إذا كان الموت –كما يصوّره الجاهلي- هو نهاية الوجود الإنساني والتوقف عن ممارسة الحياة بكل متعها، فإنّ الموقف الوجوديّ للشّاعر الجاهليّ إنّما يبرز عنيفا في تحدّيه للموت والفناء بالغوص عن لذائذها، لا حبّا في اللذّة – بوصفها لذة- ولكن حبّا في الحياة وتعلّقا بها، وكراهية في الفناء الذي تتوقّف به ممارسة هذه اللّذات”[56].
إن تأثير إيقاع الزّمان الوجودي في نفس طرفة أظهر من أن نستدّل عليه إذ الأمل الذّي يراوده في إدراك الموت قبل حضور الأجل الذّي استشعره رغم بعده منطقيّا – فالحزن قد أصاب الشّاعر في سنّ صغيرة وقد توفّي ولم يبلغ الثّلاثين من عمره – والوعي الحادّ بتناقص العمر بفعل تتالي الأيّام واللّيالي وخطوب الدّهر التي تجعل “العيش ناقصا كلّ ليلة ” على حدّ تعبير الشّاعر نفسه[57]، كلّ ذلك جعله “يبادر المنيّة بما يملك” ما استطاع و”ليست هذه المبادرة هروبا بقدر ما هي مجابهة واعية يدرك من يأتيها حدوده فيلزمها”[58] . وقد فسّر الأستاذ عليّ الغيضاوي رؤية طرفة بن العبد لمنزلة الكائن في الوجود وتحديده لها بهذه الطّريقة باعتباره اختيارا “دعت إليه سنّ الشّاعر والقيمة التي يؤمن بها وهي ممثّلة في مفهوم البذل سواء منه بذل المال أو بذل الذّات للنّجدة و الإغاثة “[59].
على أنّ البعد الوجوديّ للزّمان عند طرفة لا يستقلّ عن حضور البعد النّفسي الذي يؤكّده –على الأقلّ- تقصير المدّة الزّمنيّة المستفاد من قول الشّاعر في الشّاهد المتقدّم “تقصير يوم الدّجن ببهكنة ” إغراقا في طلب اللذّة الحسيّة ممثّلة في النّساء تحدّيا للفناء والعفاء وتمضية للوقت في اللّهو في إيقاع متسارع كأنّه الهروب من إدراك الموت ونفاد الأجل. والملاحظ أنّ تطلّب اللّذة لم يكن حكرا على طرفة وإنّما هو مسلك سلكه شعراء جاهليّون آخرون نظروا للوجود وللمصير من نفس الزاوية التي منها نظر طرفة بن العبد، فها هو امرؤ القيس يدعو إلى التزوّد بالملذّات التي تمثلها النّساء الحسان البيض درءا للموت و الفناء، فيقول: (الطويل)
تَمَتَّع مِنَ الدُنيا فَإِنَّكَ فان مِنَ النَشَواتِ وَالنِّساءِ الحِسانِ
فإيقاع الحياة سريع ودبيبها في الإنسان يدعو إلى سبقها بسلوك اللّهو والمتع والإقبال على اللذّات فما الدّنيا إلا متاع وخير متاعها النّساء، وهو المسلك الوحيد الباقي الممكن سلوكه قبل أن تنشب المنيّة أظفارها في الرّقاب فيحلّ الفناء ويتوقف الزّمن إلى الأبد. لذلك كانت الدّعوة إلى مواجهة الزّمان والتمتّع بزاد الدّنيا صريحة نتمثّلها في قول طرفة مثلا: (الطويل)
لعمرك ما الأيام إلا معارة فما استطعت من معروفها فتزود [60]
لقد صوّر طرفة بن العبد الموت ممثّلا في الدّهر الذّي لا يبقي ولا يذر بصورة من يمسك المرء بحبل إذا ما أرخي له يعيش وإذا قبض الطّول يموت ويفنى، يقول طرفة: (الطويل)
أرى العيش كنزاً ناقصاً كل ليلة وما تَنقُصِ الأيّامُ والدّهرُ يَنفَدِ
لعمرُكَ إنَّ الموتَ ما أخطأ الفتى لَكالطِّوَلِ المُرخى وثِنياهُ باليَدِ
متى ما يشأ يوما يقده لحتفه ومن كان في حبل المنية ينقد[61]
لقد تضمّنت هذه الأبيات المذكورة تعبيرا صريحا عن حسّ فاجع بالموت ونهاية الأجل بصورة من يقاد إلى حتفه بحبل حين يقبض له يموت وحين يبسط يعيش موتا “معلّقا” لكنّه آت لا محالة مادام كنز العمر ناقصا كلّ ليلة على حدّ تعبير الشّاعر نفسه. وهو تعبير مروّع يستحضر معاني الفقد في جزع وألم ويحضر إلى الذّهن ما صوّر به شعراء آخرون الموت بصور حسيّة في منتهى المأساة التي لا تقلّ وقعا عن سابقتها، إذ شبّهه زهير بن أبي سلمى بالنّاقة العمياء التي تخبط الأرض خبط عشواء فمن أصابته أدركته منيّته ومن أخطأته يردّ إلى أرذل العمر فيعمّر ويهرم، يقول : (الطويل)
رَأَيْتُ الْمَنايا خَبطَ عشواءَ من تُصب تُمِتْهُ وَمَنْ تُخطئ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ
وهو تجسيم للفناء يكشف عن حسّ فاجع للموت عند الجاهليّ
فيتضاعف عنده الإحساس بالخوف والقلق والحيرة إزاء حياة إنسانيّة مكتظّة بالشّقاء والألم فلا أحد يعرف متى وأين يدركه الأجل وتخطفه يد المنون وتصيبه ناقته التّي ليس عنها غنى، حتّى التّمائم لا تجدي معها نفعا، إذ صوّرها أبو ذؤيب الهذلي في صورة مستعارة لحيوان مفترس أنشب مخالبه الحادّة في فريسته بلا رحمة أو شفقة، يقول : (الكامل)وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع
وقد تعاور الشّعراء صورا حسية للموت جسّمت جزعهم منه، فتشابهت طرائقهم في وصفه وأكّدت على ما للزّمان – ممثّلا في الدّهر- من قسوة وسطوة على كلّ البشر وإفنائهم جميعا، فبدا الموت وحشا مفترسا عند امرئ القيس أيضا حين يقول : (الوافر)
وأعلم أنني عما قليل سأنشب في شبا ظفر وناب
ويبدو أن هذه الصّورة الحسيّة المفزعة المستدعية للموت تذكّرنا بما كان وصف به امرؤ القيس اللّيل فطالعنا في صورة الجمل الضّخم الذّي “تمطّى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل” على حدّ تعبير الشّاعر نفسه، فكان لهذه الموصوفات (اللّيل /الزّمان/الموت/الدّهر…) من الصّفات أشباه ونظائر لــ”رثاء الحياة الإنسانيّة” وهي تتردّد بين البقاء والفناء والعدم والوجود في نسق مربك حيّر الشّعراء الجاهليّين فملأ نفوسهم بالجزع أقصاه وبالألم أقساه.
5- الخاتمة:
إن شعريّة الألم في أشعار الجاهليّين قد أجلاها حسّهم الفاجع بقضايا الإنسان الموصولة بالمكان والزّمان موتا وحياة ومصيرا ورؤية للوجود أساسها وعي حادّ بجملة هذه المسائل حدا بالشّاعر الجاهليّ إلى اختيار طرائق في التّعبير والتّصوير نمّت عن “وجوديّة ” قلقة متوتّرة استشعرت الفناء منتهى فأعقبت في نفسه ألما وأورثته حسّا مأساويّا أجلاه الأدب الذّي هو في جوهره “مأساة أو لا يكون” على حدّ تعبير محمود المسعدي .
ولئن تخيّرنا من الموضوعات ما رأينا فيها تمثيلا صادقا –شعوريّا على الأقلّ – لمعنى الألم وتصويرا معبّرا عن حسّ الفاجعة الإنسانيّة كالوقفة الطلليّة وليل امرئ القيس وتجارب بعض شعراء الجاهليّة في مواجهتهم للزّمان، فإنّنا أغفلنا من المواضيع ما له صلة بالمعنى المطروق ذاته، ونقصد بذلك الرّثاء باعتباره من الأغراض التي لا تنحصر في إطار الحيّز الزّمني الذّي نحن بصدده، وإنّما نجد له امتدادا في العصور اللاّحقة لعصر الجاهليّين، وهو يحمل – في ما يحمل– من السنّة الشعريّة مبنى و معنى ما يحيل على كونه غرضا تأسيسيّا. هذا فضلا عن أنّ تجليّات الألم التّي يكتمنها والتّعبير عن الحسّ الفاجع بالموت وتناهي البشر –في جانب كبير منها – قد تضمّنتها رؤية الجاهليّين للزّمان الذّي عرضنا له في القسم الثّالث من البحث. على أنّ ضيق المقام قد مثّل السّبب الرّئيس في عدم ذكر الرّثاء مقالا من مقالات شعريّة الألم عند الجاهليّين.
وجملة القول فقد مثّل التّعبير عن البقاء والفناء محور الإحالة على الوعي المتشائم بالوجود والحياة والموت واستشعار الحتف وتسارع الزّمان الذّي ينتهي بالإنسان إلى التّناهي و الزوال. ولئن دلّلنا على حضور تلك الدّلالات في نماذج شعريّة أكّد أصحابها على هذه المعاني فإنّنا غضضنا الطّرف على شعراء آخرين تمثّلوا هذه الأبعاد المذكورة خير تمثّل إلاّ أن المقام لم يتّسع كثيرا لمقالهم، واقتصرنا – في ما اقتصرنا عليه– على ما ارتأينا أنّهم استقطبوا شعريّة الألم في أبعادها المختلفة مكانا وزمانا وإنسانا …
ولعلّ أبرز ما يلفت الانتباه في وقوف الشّعراء الجاهليّين عند هذه التجلّيات أنّهم قد حاولوا الانتصار على الانكسار الذي يسكنهم وأعلنوا تحدّيهم لما يتهدّدهم من ضيق أو حزن أو حتى انتهاء وفناء بما يتماشى مع قناعاتهم وقيمهم التي رسخت وسارت بين الناس، فحاولوا – في ما حاولوه – أن يُحلّوا الماضي السّعيد في حاضر الوعي من خلال الذاّكرة كما استعاضوا عن الألم والهزيمة بما يمكن أن يثبت الفنّ (الشعر) عكسه رمزيّا، فكانت الحيوانات التي تخوض صراعا مع الوحوش والكواسر دائما تنتصر باعتبارها معادلا موضوعيّا للشّاعر الجاهليّ بها يحتمي ويتحصّن ممّا يتهدّده من الأخطار والفواجع … وفي نفس السّياق خلع الشّاعر على نفسه من الصّفات ما رأى أنّها تخفّف عنه وطأة الألم ووعيه الفاجع بالمكان مرّة وبالزّمان أخرى و بالإنسان ثالثة. وعليه، فقد كان مفهوم البطولة محورا تدور عليه أشعار الجاهليّين على اختلاف مذاهبهم وتنوّع أغراضهم الفنيّة.
المصادر والمراجع:
- إبراهيم (زكرياء): مشكلة الإنسان، دار مصر للطباعة والنشر، د.ت.
- السلام محمد هارون، ط 1980. (ط1/1963) .
- أحمد (محمود محمد): ملامح الحزن في المعلقات الجاهلية – مقال على شبكة الانترنت. 10/01/2012.
- إسماعيل (عز الدين): أصالة الشعور في الشعر العربي، مجلة الشعر، ع 2 .د .ت.
- ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم): شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ت عبد
- ديوان امرئ القيس، ت. محمد أبي الفضل إبراهيم طبعة دار المعارف بمصر 1984(ط1 .1958). ضمن سلسلة ذخائر العرب ع 34.
- ديوان بشر بن أبي خازم: مطبوعات وزارة الثقافة دمشق.
- ديوان عمرو بن قميئة: شرح و تحقيق: خليل إبراهيم العطية، دار الحرية للطباعة، بغداد 1972 .
- ديوان النابغة الذّبياني: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، 1977.
- ديوان الهذليين: الدار القومية للطّباعة والنشر، القاهرة- 1965.
- ذو الأصبع العدواني: ديوانه جمع وتحقيق عبد الوهاب محمد العدواني ومحمد العدواني ومحمد نايف الدليمي العراق /الموصل-1973.
- رومية (وهب أحمد): شعرنا القديم والنقد الجديد، عالم المعرفة ع 207 – الكويت – مارس 1996.
- طشطوش (عبد العزيز محمد موسى ): الزمن في الشعر الجاهلي ط.اليرموك 1983.
- العسكري (أبو هلال): ديوان المعاني، ط. بغداد . القاهرة 1352ه .
- العطار(سليمان ): شرح المعلقات السبع. تبسيط الشروح القديمة دار الثقافة للطباعة والنشر – القاهرة 1982 .
- ناصف (مصطفى): قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار لبنان للطباعة و النشر، د.ت.
[1]– الغيضاوي: الإحساس بالزمان في الشعر العربي من البداية إلى نهاية القرن الثاني للهجرة . بحث لنيل شهادة دكتوراه دولة في اللغة والآداب العربية (ج.2) .1997-1998- ص 424.
[2]– رومية ( وهب أحمد ): شعرنا القديم و النقد الجديد، عالم المعرفة ع 207 – الكويت – مارس 1996 ، ص314.
[3]– شعرنا القديم و النقد الجديد ،مرجع سابق، ص 315.
[4]– شعرنا القديم والنقد الجديد، المرجع السابق نفسه، ص317.
[5]– المرجع المذكور نفسه، ص317.
[6]– شعرنا القديم والنقد الجديد، المرجع السابق نفسه ص329.
[7]– أحمد (محمود محمد): ملامح الحزن في المعلقات الجاهلية – مقال على شبكة الانترنت. 10/01/2012 ص3.
[9]– إسماعيل ( عز الدين ): أصالة الشعور في الشعر العربي ، مجلة الشعر ، ع 2 .د .ت. ص 3.
[10]– ناصف (مصطفى): قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار لبنان للطباعة و النشر، د.ت. ص 55.
[11]– الديوان، 114.
[12]– إبراهيم (زكرياء): مشكلة الإنسان، دار مصر للطباعة والنشر، د.ت. ص 82.
[13]– ديوان عمرو بن قميئة: شرح و تحقيق : خليل إبراهيم العطية ، دار الحرية للطباعة ، بغداد 1972- ص47.
[14]-ديوان بشر بن أبي خازم : مطبوعات وزارة الثقافة دمشق ص19، 33-34.
15 الأدب الجاهلي: مرجع مذكور سابقا، و الرأي مأخوذ عن سليمان العطار: شرح المعلقات السبع، تبسيط الشروح القديمة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 1982، ص46
[16]– العطار (سليمان): شرح المعلقات السبع: مصدر مذكور سابقا، ص97.
[17]– الغيضاوي: الإحساس بالزمان، مرجع مذكور سابقا، ص317.
[18]– ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم طبعة دار المعارف بمصر 1984( ط1 .1958).ضمن سلسلة ذخائر العرب ع34.
[19]– الإحساس بالزّمان، مرجع مذكور سابقا، ص 355
[20]– المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
[21]– ديوانه، قصيدة 32.
[22]– الإحساس بالزّمان، ص356.
[23]– الأدب الجاهلي، مرجع مذكور سابقا، ص304.
[24]– الديوان، ص40-41.
[25]– الإحساس بالزمان، مرجع مذكور سابقا، ص351.
[26]– المرجع المذكور نفسه، ص359 . والبيت من الديوان ، قصيدة 55.
[27]– الديوان، قصيدة 68.
[28]-الإحساس بالزّمان، ص365.
[29]– طشطوش (عبد العزيز محمد موسى): الزمن في الشعر الجاهلي، ط. اليرموك 1983، ص135.
[30]-الإحساس، مرجع مذكور سابقا، ص365.
[31]– ديوان الهذليين : الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 1965، 2/62.
[32]– ديوان الهذليين، مصدر مذكور سابقا،2/201. ذكره طشطوش في المرجع السابق.
[33]– الزمن في الشعر الجاهلي، مرجع مذكور سابقا، ص145.
[34]– ديوان النابغة الذّبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، 1977 -ص38.
[35]– ديوان امرئ القيس: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم –دار المعارف بمصر ، ط3-1969 -18/19.
[36]– شعرنا القديم والنقد الجديد، مرجع مذكور سابقا، ص234.
[37]– العسكري (أبو هلال) : ديوان المعاني، ط . بغداد القاهرة 1352ه ، ص346- ذكره الغيضاوي في كتابه : “الإحساس بالزمان”ج2،ص35.
[38]– نفس المصدر، ص346- والشاهد ذكره الغيضاوي في المرجع المذكور السابق ،ص355. و البيت الذي عليه مدار القول للطّرمّاح هو: على أن للعينين في الصبح راحة بطرحيهما طرفيهما كل مطرح.
[39]– الديوان: مصدر مذكور سابقا، ص 164.
[40]– الديوان، ص118.
[41]– الديوان، ص157.
[42]– الأدب الجاهلي، مرجع سابق، ص301.
[43]– ذو الأصبع العدواني: ديوانه جمع وتحقيق عبد الوهاب محمد العدواني ومحمد العدواني ومحمد نايف الدليمي العراق /الموصل-1973.
[44]– الإحساس بالزمان: مرجع مذكور سابقا، ص493.
[45]– المرجع السابق، ص 495.
[46]– شعرنا القديم والنقد الجديد، مرجع سابق، ص282.
[47]– الإحساس بالزمان ، مرجع سابق، ص372.
[48]– المرجع السابق، ص424.
[49]– المرجع نفسه، ص368.
[50]– الديوان، ص157.
[51]– الأدب الجاهلي، مرجع مذكور سابقا، ص300.
[52]– المرجع نفسه، ص 301.
[53]– الديوان، ط لندن، ص38.
[54]– الديوان، ص 385.
[55]– الديوان، ص505.
[56]– د.عفت الشرقاوي: دروس ونصوص في قضايا الأدب الجاهلي، ص 287- ذكر في الأدب الجاهلي ، ص 348.
2- ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم) : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، ت عبد السلام محمد هارون ، ط 1980.(ط1/1963) سلسلة ذخائر العرب، عدد 35-ب 66.
[58]– الإحساس بالزمان، مرجع سابق، ص 367.
[59]– المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
[60]– ديوان طرفة، ص178.
[61]– ابن الأنباري، مصدر سابق.