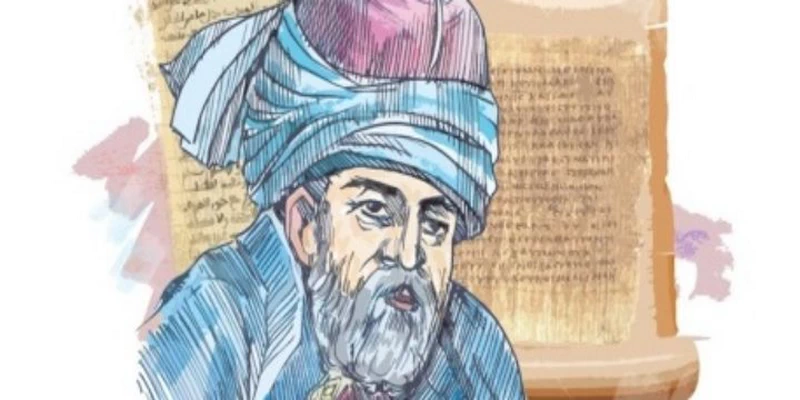ملخّص:
حاولنا في هذا المقال اِكتشاف علاقة “التّناصّ” بالسّرقات الشّعرية في الدّراسات النّقدية البلاغيّة القديمة، ذلك أنّ الرّؤية النّقديّة للجرجاني التي تناولت مبحث السّرقات الشّعريّة ظلّت محكومة بالمحدّدات الجماليّة والفنّية وهي تعالج السّرقة معالجة بلاغيّة بحثا عن مكان الأدبيّة والشّعريّة التي ينفتح بها النّصّ على نصوص أخرى ويتفاعل معها لتظلّ ممارسة النّصّ إنتاجيّة لها قدرة تفجير المتداول والمشترك.
الكلمات المفاتيح: السّرقات، الأدبيّة، التناصّ، الإنتاجيّة، التّفاعل.
Abstract:
Plagiarism focuses on originality We tried in this paper to explore the correlation between plagiarism and intertextuality in classical Arabic critical rhetoric. For instance all January’s vision about the issue was confined to the poetic and aesthetic fields while treating plagiarism rhetorically just to define its aesthetic and poetic point, lie. As a result, texts open up on one another and merge interactively to keep text practice productive and fruitful to be able to dichotomize the regular and common.
Keywords: plagiarism, intertextuality, productive, interactively.
تمهيد:
يندرج اهتمامنا في إطار انشغالنا بسؤال السّرقات الشّعريّة[1] يندرج في إطار اِنشغالنا بمتابعة نظريّة الإبداع الشّعريّ العربيّ ومحاصرة وجوه أدبيّته بناء على طريقة تفاعله مع النّموذج الشّعريّ السّابق عليه، ومدى محافظته على مكوّناته الفنّية. وقد ظلّت مسألة السّرقة علـــى اِمتداد الخطــــاب النّقدي سؤالا فنيّا وجماليّا، إذ اُعتبِرت السّرقات سؤالا بلاغيّا يَرمي إلى إنصاف الشّعراء وإبراز مظاهر تجاربهم الإبداعيّة وتخليصها من أسر سؤال الأخلاق والسّياسة[2]ناهيك أن السـّرقات الشّعرية كانت وسيلة لتجريح الشعراء[3]. وغاية إثارتنا لهذا الموضوع هو معرفة طبيعة الرّؤية النّقديّة العربيـــّة في معالجتها للعلاقات النّصّيّة، وهــــي تنأى بالسّرقة عن سؤال الأخلاق والسّياسة لتهتمّ بها سؤالا بلاغيّا وأدبيّا. ومن هذا المنطلق، توقّفنا عند مســاهمة عبد القاهر الجرجانيّ في القرن الخامس الهجريّ لتبيّن الطّريقة التي حوّل بها الخطـــاب النّقديّ البلاغيّ مبحث السّرقات من دائرة السّياسة والأخلاق إلى مجال الدّراسة البلاغيّة والأدبيّة الصّرف. إجابة على السّؤال المركزي: ما هو المبدأ الفنّي المتحكّم فـــــي بناء النصّ الأدبيّ كما استقر في الشعريّة العربيّة القديمة؟ أهــــــــو الإبداع المعتمد على الغرابة أم التّوليد المؤسّس على التّفاعل بين النّصوص؟
1- صورة المعنى بين التّماثل والاختلاف في طرح الجرجانيّ:
لا جدال في أنّ الإبداع العربيّ ملتبس بعضه ببعض، وآخذ بعضه برقاب بعض حتى إنّه ” ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم، والصبّ على قوالب من سبقهم”[4]. لذلك نوه النّقاد العرب بدور الحفظ والرّواية في تكوين الشّعراء المجيدين حد مسايرة النّموذج الشّعريّ السّابق عليهم. وفي هذا السّياق الفنّيّ العامّ، نشأت السّرقات الشّعريّة، التي اتخذها النّقاد العرب مدخلا نظريّا لمتابعة حركيّة الإبداع الشّعري ومحاصرة أدبيّته تبعا لتفاعله مع النموذج الشّعري السّابق. وتسعفنا قراءة مؤلّفَيْ الجرجانيّ الذيْن اِهتمّا بظاهرة المعاني المشتركة العامّــــة والظّاهرة الجليّة بالوقوف عند حقيقة التّوارد على مثل هذه المعاني الخارجة عن مدار السّرقة، لأنّ المعاني إرث جامع ومشترك يغترف منها الشّعراء جميعهم، نحو أن يقصد الشاعر إلى وصف ممدوحه بالشّجاعة والسّخاء أو غير ذلك. فمثل هذا المشترك لا فضل فيه لشاعر على آخر، لأنّه مـن المشترك لا في عموم الغرض فحسب، و إنّما في وجه الدّلالة على الغرض أيضا. وبذلك فإن هذا الاتّفاق في عموم الغرض ومعانيه أوفي صور الشّعر وأساليبه ” لا يكون الاشتراك فيه داخلا في الأخذ و السّرقة والاستمداد والاستعانة. وكذلك الاتّفاق في وجه الدّلالة على الغرض، وإن كان مما يشترك النّاس فـــي معرفته، وكان مستقرّا في العقول والعادات فإن حكم ذلك وإن كان خصوصا في المعنى حكم العموم من ذلك التّشبيه بالأسد في الشّجاعة وبالبدر في النّور، وكان ذلك ممن حضرك فــــي زمانك أو كان ممن سبق في الأزمنة الماضية، لأن هذا ممّا لا يختصّ به قوم دون قوم، ولا يحتاج في العلم إلى روية واستنباط”[5]. ومن هنا فإنّه بوسعنا أن نماثل بين هذا المشترك العام وطبيعة اللّغة باعتبارها رصيدا جمعيا شائعا الذي يغترف منه النّاس في كلامهم ومخاطباتهم. فإذا بهذا المشترك ينفتح على مفهوم الكفاءة الذي يظل مجال التمثّل والاستعمال. ثم إذا أدركنا أن اللغة مواضعة في جانبها الأكبر، يمكننا اعتبار هذه الصور في مجال المواضعة، وقد أضحت بمفعول التداول والاستعمال حقيقة ونسيت أصولها الأولى التي انطلقت منها[6]. وبذلك فإنّ هذا المشترك الذي يكون فيه الاتّفاق من حيث وجه الدلالة على الغرض، لا يقع فيه التفاضل، أو يدّعى فيه الاختصاص، ومن ثم فهو مما لا يدخل في الأخذ والسّرقة. أما النوع الثاني من المعاني، فهو نوع خاص ينتهي إليه المتكلم بنظـــر و تدبّر، ويناله بطلب واجتهاد، و هو الذي يجوز فيه الاختصاص والسّبق والتقـدّم و الأوليّة، وأن يجعل فيه سلف وخلف ومفيد ومستفيد، وأن يقضي فيه بين القائلين بالتّفاضل والتّباين، وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر، وأنّ الثاني زاد على الأوّل أو نقص عنه و ترقى إلى غاية أبعد مـــــــــــن غايته، أو اِنحطّ إلى منزلة هي دون منزلته[7]. علـــــى أنّ الخاص فـــــي طرح الجرجانـــــي لا يعني بالضرورة ابتداعا من عدم، بل هو نتيجة التّفتيش والتّوليد، وهذا يعني ضربا مـــــن التحـويل بالتحسين والزيادة. هكذا استطاع عبد القاهر الجرجانــي بناء نظريّته فــي المعاني الشّعرية، بتمييزه بين المعانـــي المشتركة أو المتداولة، والمعانــــي الخاصة أي الشّعريّة “ليدخل بذلك فـــي الســــؤال الجوهري سؤال الأدبيّة “[8]. سيما أنّ الجرجــــــاني لم يقف فـــي تعامله مع قضية السّرقة عند حدود تقرير الأصول العامة فـــــــي مستوى المعاني العامة المشتركة والظاهرة الجليّة، بل سلك مسلكا بلاغيّا ولسانيّا طريفا، حين أقرّ بإمكانيّة التّفاضل بين الشّعــــــراء فــــــي مثل هذه المعاني المشتركة، يقول النّاقد : ” واِعلم أنّ ذلك الأوّل وهو المشترك العاميّ و الظــّــاهر الجليّ، والــــذي قلت إنّ التّفاضل لا يدخله، والتّفــــاوت لا يصحّ فيه، إنّما يكون كذلك منه ما كان صريحا ظاهرا لم تلحقه صنعة، وساذجا لم يعمل فيه نقش. أمّا إذا ركب عليه معنى، ووصل به لطيفة، ودخل إليه من باب الكناية والتّعريض والرمــز والتّلويح، فقد صار بما غُيّر في طريقته، واستؤنف من صورته، واستُجدَّ له من المعرض، وكسي من دلًّ التعريض، داخلا في قبيل الخاص الذي يُمتلك بالفكرة والتَّعمل ويُتوصل إليه بالتدبر والتأمل[9]“. نخلـــص مما تقدم أن هذا التّمييز بين المعاني المتداولة من ناحية، والمعاني الخاصّة مـن ناحية أخــــرى، يعكس بحق طبيعة الرّؤية النّقدية لدى الجرجاني، في متابعتها لمبحث السّرقات الشّعرية، ومعالجته معالجة جمــــاليّة وبلاغيّة فريدة و قريبة من التّصوّر الدّلاليّ للتّناصّ فــــي الطّرح النّقديّ الحديث، انطلاقا مـــــن فهم دقيق وعميق لخصوصيّة الظّاهرة النّصيّة، بما تقـــــوم عليه مــن تشاكل واختلاف. وما مكّن عبد القاهر الجرجاني من اِجتراح مصطلحات ومفاهيم تنسجم و المدخل الجماليّ و البلاغــيّ للسّرقات في الشّعرية العربّية القديمة، بعيدا عن المدخل الأخلاقيّ و السياسيّ. وقد اهتمّ بمفهوم الأخذ كبديل للسّرقة في التّعامل مع مكوّنات الذّاكرة الشعريّة. و تنبّه هذا الناقد إلى أهميّة الزّيادة فــي إخراج المعنى بما من شأنه أن يبعد الشّعراء عن مذمّة السّرقة، ويمكّنهم مــــــن التّفاعل الإيجابـــيّ مع نماذجهم الفنّيّة السّابقة. ويستشهد الجرجانيّ بمثل يضرب للذي يخاف من شيء فيحذره ثم يصيبه آخر ممّا لم يخفه وهــو”حرّا أخاف على جانبي كمأة لا قرا ” وقد توارد عليه شاعـــــــران من القدماء وثالث من المحدثين فقال الأوّل: (الكامل)
وحذرتُ من أمر فمرَ بجانبي لم يُنكني ولقيتُ ما لم أحذًر
ثمّ قال لبيد: (البسيط)
أخشى على أربَدَ الحَتُوفَ ولاَ أرهبُ نَوءَ السمَاك والأسَد
وأضاف البحتري: ( الكامل )
لَو أنني أُوفي التجاربَ حقها فيمَا أردتُ لرَجَوتُ ما أخشَاهُ
ويستوقفنا تعليق الجرجانيّ على هذا التّناول مفاضلا ” لقد أحسن البحتريّ و طغى اقتدارا علـى العبارة واتّساعا في المعنى[10]“. ويبدو أن هـــــــذا الاحتذاء هو الذي جعل الممارسة النّصيّة عبر الشّعراء الثّلاثة بالتّطوير والتّحسين، حتى كادت النّصوص الجديدة أن تعفي على النّصّ القديم، لأنّ المعنى في النّصّ القديم جاء غفلا غير مصنوع، في حين جاء في النّصوص الأخـــرى مصنوعا بالتّفتيش والتّدبّر[11]. ولعلّ مكمن الطّرافة أنّ عبد القاهر الجرجانيّ في إطار معالجته للمعاني الشّعريّة، يجعل الموازنة قائمة على المعنى في اكتماله الدّلاليّ و لا يسوقها في مساق السّرقة، بل أخرجها في ثوب إبداعــيّ يبرز القدرة علــــى التّجاوز. ولا عجب في ذلك، فإنّ الاحتذاء ” أخذ له قدرة الخلق، والسّرقة أخذ خال مـــن هذه القدرة، والفرق بينهما هو الفرق بين الفنّان والسّارق، فالفنّان ناقل جيّد، والسّارق ليس إلاّ ناقــــــلا رديئا[12]“. ناهيك أنّ هذا الأخذ في النّهاية لا يقف عند حدود المسايرة أو مجرّد اِحتواء النّصّ اللاّحق لنّص أو نصوص سابقة، بل هو أخذ يتعامل مع النّموذج الشّعريّ القديم تعاملا تحويليّا ونحن نزعم أنّه بقدر التّفاعل بين النّصوص وفقا للقوانين التّحويليّة، تتجلّى الشّعريّة التي ينفتح من خلالها النّصّ علـى أبعاده اللانهائيّة ممّا يدعونا إلى عدم الفصل بين مفهوم السّرقة ( الأخذ ) في التّصوّر النّقديّ البلاغــــيّ للجرجاني و مفهوم الأدبيّة لأنهما يبحثان في جماليّة النصّ من حيث هو بناء جامع . خاصة أنّ النـّـــــصّ الأدبيّ لا يتعالق مع نصوص من نفس الجنس الأدبيّ الواحد فحسب، بل يتعالق أيضا مع نصــوص من أجناس أخرى ليكون وليد حوار النّصوص وتفاعلها. وإذ تبيّن أنّ السّرقة، كما اِستقرّت فـــي طـرح عبد القاهر سؤال بلاغيّ وأدبيّ فنيّ، الهدف منه الكشف عــــن أدبيّة النّصوص والموازنة بين الشّعراء. فإنّ اِحتفال الجرجاني بالنّظم والتّصوير كان حاسما في تشييد أفق بلاغيّ و لسانــيّ لقضيّة السّرقات الشّعريّة التي كثيرا ما أرهقت المحاولات النّقديّة قبله، معبّدا بذلك للشّاعر طريقا فنيّا ينفذ مـــــن خلاله إلى ذاكرته الفنيّة بعيدا عن تجريح النّقاد ومذمّة السّرقة .
2- نظريّة النّظم والأفق البلاغي واللسانيّ لقضيّة السّرقات الشّعريّة[13]:
لم يتردّد الجرجانيّ من خلال كتابيه “أسرار البلاغة” و”دلائل الإعجاز” في إثبات أن سبيل المعانـي “أن ترى الواحد منها غفلا ساذجا عاميّا موجودا في كلام الناس كلّهم، ثم تراه نفسه وقد عمد إليه البصير بشأن البلاغة وإحداث الصّور في المعاني، فيصنع فيه ما يصنع الصانع الحاذق، حتــــــى يُغرب في الصنعة، ويدق في العمل، ويبدع في الصّياغة[14]“. ويبدو أنّ هذا التّصـــوّر لا يمكن أن يتمّ إلاّ بإنشاء كلام فنيّ يأبى التّشابه ويحقق الاختلاف. لذلك يقرّ عبد القاهر بأنّ طريقة التّأليف الشّعـــري، التي يسمّيها ” النّظم”، هي أساس التفاضل الفنيّ بين الشعراء في اغترافهم من المأثور، أومن المعاني العامّة المشتركة. ومن هنا فقد اِستطاع الجرجانيّ تخليص المعنى من عقال المضامين الأخلاقيّة التّهجينيّة للسّرقات الشّعريّة، ومن تأثير التّشريعات الشّعريّة لعمود الشّعر. لأن مدار النّظم على معاني النّحو، ومعلوم أنّ معاني النّحو تنفتح على فضاءات إبداعيّة تعززّ وجوه الفروق بين التّجارب الشّعريّة وذلك لأنّ معاني النّحو” التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجـــاز من بعدها من مقتضيات النّظم و عنها يحدث وبها يكون، لأنّه لا يتصوّر أن يدخل شيء منها في الكلم وهـي أفراد لم يتوخّ فيما بينها حكم من أحكام النّحو[15]“. ونحن نرجّح أنّ حديث الجرجانيّ عن المعنـى النّحويّ، أو معنى المعنى قياسا إلى المعنى، يدخل في باب التّمييز بين المعنى والدّلالة، على اِعتبار أنّ المعنى ” لغويّ ” والدّلالة “نصوصيّة”. مع ما يتعلق بالمعنى من ثبات، وما يسكن معنى المعنى من تحوّل أو تغيّر.
وعليه فإنّ التّفريق بين “المعنى ومعنى المعنى”في طرح الجرجانيّ هو تمييز بين المعنى في اللّغة والدّلالة فـــــي الأدب. وربما يكون تفريق عبد القاهر بين المعنى والدّلالة، مؤشّر على عمق معنى المعنى كدلالة نصوصيّة مفتوحة على لانهائيّة الإنتاج و الابتناء، في مقابل جاهزية المعنى اللّغويّ و سطحيّته.
وإذ تبيّن أنّ الجرجانيّ قد قدّم مفهوما جديدا للمعنى، عقده على المعنى الخاصّ الذي لا يمكن أن يتحقّق إلا بتوخّي معاني النّحو في معاني الكلم. فقد أعطــــى بذلك حريّة التّفّرّد المعنويّ للشّاعر، خاصة أنّ عبد القاهر قد “تواردت في ذهنه خواطر متشابكة عن العلاقة بين المعنى فــــي النحو والمعنى في الزّخرفة والمعنــــى فــــي جماليّات الشّعر، وبعبارة أخـــــرى، شعر بصلة غامضة بين هذه الجوانب[16]“.
ولتوضيح ذلك، أورد الجرجاني بيتا لبشّار: ( الطّويل )
كأنّ مثَارَ النّقع فوقَ رُؤُوسنا وَأَسيَافنَا لَيلٌ تَهَاوَت كَوَاكبُه
فأقرّ أنّ بشّار لم يحضر معاني هذا الكلم عارية من معاني النّحو، و نفى أن يكون قد أورد ” كأنّ” فـــي نفسه دون أن يقصد إيقاع التّشبيه منه على شيء، وأن يكون قد فكّر في “مثار النّقع” من غير أن يكـــون قد أراد إضافة الأوّل إلى الثّاني، وفكّر في “فوق رُؤُوسنا” من غير أن يكون قد أراد أن يضيف “فـــوق” إلى الرّؤوس، وفي الأسياف من دون أن يكون أراد عطفها بالواو على “مثار”، وأن يكون قد فكرّ فـــي اللّيل من دون أن يكون أراد أن يجعله خبرا لكأنّ، ثم يجعل الجملة صفة للّيل الذي أراد مـــــــن التّشبيه[17]. وبذلك فقد أتم بشّار التّشبيه، وغيّر من هيئة السّيوف المسلولة من أغمادها وهي تعلو وترسب، وكـان لهذه الزّيادة حظّ من الدّقة ولطف التّأثير راعى بها لشّاعر ما لم يراعه غيره، كقول المتنبي:(الطـــــويل)
يَزُور الأعادي في سماء عَجَاجَة أَسنّتُهُ في جانبَيهَا الكواكبُ
أو قول كلثوم بن عمرو:(الكامل)
تَبني سَنَابكُها من فَوق أرؤسهم سَقفا كواكبُهُ البيضُ المباتيرُ
فرغم التّشابه بين هذه النّصوص في تشبيه لمعان السّيوف في الغبار بالكواكب في اللّيل، فقد حكــــــم عبد القاهر لبشّار بالتّفوق لأنّــــه أحدث في التّشبيه حركة داخليّة هـــي انعكاس حركة العين للحركة الخارجية والتقاط مظاهرها وإخراجها من حيّز التّصور إلـــــى حيّز التّصـــــوير[18] على نحو أثبت من خلاله الجرجاني أنّ ممارسة النصّ تظلّ إنتاجيّة، لها قدرة تفجير المتداول والمشترك اعتمادا على الخبرة الفنيّة والجماليّة. هذه الخبرة التي من شأنها أن تنزاح عن النسق البلاغيّ لصورة نمــــوذجيّة مستهلكة، وتعيد بناء مكوّناتها الأصليّة لجعلها أكثر شعريّة. ونحسب أن ما يسمّيه عبد القـــاهر الجرجانــــي بالبناء علـى التّشبيه، يظل أحد أهم المعايير الفنّيّة التي تتحقّق بها المزيّة البلاغيّة للكلام الشّعريّ.
3- خاتمة:
نخلص ممّا تقدم أنّ هذه الرّؤية النّقدية للجرجانيّ التي تناولت مبحث السّرقات الشّعرية، ظلت مخلصة فـــي جُلّ جوانبها للمحدّدات الجماليّة والفنّية، وهـــي تعالج السّرقة معالجة بلاغيّة قريبة مما اِستجدّ فـي الدّراسات النّصيّة الحديثة، من تناول لمستويات التّداخل النّصـّـيّ بوصفه ضربا من المراوحة بين الإثبات و النّفي كما تقول جوليا كرستيفا[19]. هـــــذا فضلا عن تأكيد الجرجانيّ علـى أنّ تنامي النّصّ جماليّا ودلاليّا لا يمكن أن يتحققّ إلاّبتقنيّات تعبيريّة خاصّة ترسم للنّصّ دلالاته الشّعريّة، لسبب رئيس وهو أنّ عبد القاهر لم يبحث في الدّالّ وحده ولا في المدلول وحده كما هو الشّأن بالنّسبة إلى الآمدي أو غيره مـن النّقاد. بل اِهتم بشبكة العلاقات المتبادلة بينهما، التـــي تشمل طرق اِنتظــــام وســائل النّصّ الإشـــــــاريّة والمجازيّة لتحقيق فاعليّة دلاليّة وجماليّة مميزة.
قائمة المصادر و المراجع:
المصادر:
- الجرجاني (عبد القاهر ت481هـ)، دلائل الإعجاز، طبعة مطبعة السعادة بمصر (د.ت)، أسرار البلاغة، تعليق محمود محمد شاكر، دار المدني بجدّة، ط جدّة 1991.
- العسكري (أبو هلال ت 395هـ) علي محمد البجاوي، كتاب الصناعتين ، الكتابة و الشعر، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. منشورات المكتبة العصريّة بيروت لبنان، 1986.
المراجع العربية:
- التّنيسي (ابن وكيع)، المنصف في نقد الشعر و بيان سرقات المتنبّي و مشكل شعره تحقيق محمد رضوان الداية، دار قتيبة للطباعة و النشر 1875.
- العمري (محمد)، البلاغة العربيّة، أصولها و امتداداتها، منشورات أفريقيا الشّرق، بيروت، لبنان ط م، 1994.
- المصفار (محمد)، التّناصّ بيت الرؤية والإجراء في النقد القديم، مقاربة محايثة للسرقات الأدبية عند العرب، مطبعة التفسير الفني، صفاقس تونس، ط 2000.
- ناصف(مصطفى)، نظرية المعنى في النقد العربي، دار الأندلس، بيروت. ط2، 1981.
المراجع الأجنبية:
Kristeva Julia,Semiotiké, Recherche pour une sémanalyse, Ed. Du Seuil 1974.
[1]– السّرقة :اسم من الفعل سَرَقَ: فـ “سَرَقَ منه مالا يسرق سَرَقًا بالتحريك، والاســــــم السَّــــــرقُ والسرقةُ بكسر الـــــراء فيهما جميعا. واسترق السمع، أي استمع مستخفيا. ويقال: هو يُسارق النظر إليه، إذا اهتبل غفلته لينظر إليه. (الجوهري، الصحاح، مادة: سرق) . ويفـــــرق ابن منظور بين السّرقة وما شابهها، فيقول : السّارق عند العرب من جاء مُستَترا إلــى حرز، فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ مــن ظـاهر فهــــو مُختًلسٌ ومُستَلبٌ و مُنتَهبٌ، فإن منع مما فـــــي يديه فهــــــــــــــو غاصبٌ. (لسان العرب، مادة: سرق). بهذا يجد الباحث نفسه أمام مجموعة من المصطلحات التي ستُقَاربُ السّرقة منها: الاختـــلاس، والسّلب، والنّهب، والغصب. والملاحظ أن البلاغيّين العرب قد اهتمـــّوا اهتماما مُتباينا بموضــوع السّرقة، كما تباينت مواقفهم بشأنها، من ذلك مثلا أنّ ابن قتيبة نأى عــــن ذكر لفظ السّرقة عــــــن الشّعراء المسلمين، مُستبدلا إياها بألفاظ مثل: الأخذ، والسّلخ، والاتّباع. بينما تحدث الجرجاني مختصــرا مجملا في كتابه ” أسرار البلاغة ” عن مفهوم الأخذ (السرقة ) فـــــي إطار وضعه لنظريّته عـــن تقسيم المعاني إلى عقلية وتخييليّة، ويُعتبر كلام الجرجاني تأسيسيّا في هـــــذا الباب، مع أنّه لم يضع تعريفا ضـــــابطا للمصطلح أو غيره من المصطلحات التي أشار إليها في سياق كلامه المجمل، والتــــي منها: الاقتداء، والاستمداد، والاستعانة. والمهم هو أن ندرك، أن البلاغييّن العرب لم يتفقوا في مصطلحاتهم، ســـــوى علـــى معنى الأخذ والسّلخ، كما أنّهم افترقوا غاية الافتراق في باقي المصطلحات. على أنّ الأهـــــــم في هذا السّياق، هو التأكيد على قدم الظاهرة، أي” العلاقات النصيّة “،أو تداخل النّصـــوص ممارسة واصطلاحا، وإن اختلفت المسمّيات، وتباين النّقاد في ضبط المصطلح .
[2]– تكشف مضامين المدونات النّقدية العربيّة القديمة، أن السّرقات الشّعريّة استقرّت عند بعض النّقــــاد بوصفها سؤالا أخلاقيّا وسياسيّا. ويكفـــي أن نعود تمثيلا لا حصرا إلـى كتاب: الرسالة الموضحة، حتى يتّضح لنا أن الدّافع الذي يحرّك الحاتميّ فـــي مساءلة المتنبّي في شعره، إنّما كان دافعا سياسيّا، ولم يكن فنيّا خالصا. بدليل أن رسالته كانت إرضاء لرغبة الوزير المهلبي الذي تقاعس المتنبّي عن مدحه .
وفي هذا يقول:” لما تثاقل أبو الطيّب عن خدمته (أي الوزير المهلبي) وأساء التوصّل إلى استنزاله عن عرفه، ولم يوفّق لاستمطار كفّه. وكانت واكفة البنان منهلة باللّجين والعقيان، سامني هتك حريمه، وتمزيق أديمه، ووكلني بتتبع أشعاره، وإحواجه مفارقة العراق، (…) وحسبي علم الرئيس بحقيقة الحال
وصــدق المقــال وتبرير الفعــال ونهوضــي فــي حدثــــان الشَّبيبة بما قصــــرت عــــــن جملته همم الرجال”.(الرّسالة الموضحة، ص2،3) أما ابن وكيع التنسيني فقد ألّف كتابه المنصف فـــــي نقد الشعـــر و بيان سرقات المتنبّي ومشكل شعره، بإيعـــاز من دوائر السّلطة التـــــــي كانت معادية للمتنبّي حين أقام بمصر. فأثار حقد ابن حنزابة لترفّعه عن مدحــــه. وحين غـــــادر مصر هاجيا كافورا والطّبقة الحاكمة بأكملها. (محي الدين صبحي، نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي فــــــــي القرن الرابع الهجري، الدار العربية للكتاب، تونس ط1، 1981. ص 40
[3]– ارتبطت السّرقات الشّعرية فــي الكثير من جوانبها بتجريح الشّعراء. من ذلك مثلا أن النّقد الذي دار حول شعر أبــــــي الطيب المتنبّي كان فـــــــي مجمله وسيلة غير فنيّة استعملت لتحقيق أهـــداف سياسيّة وشخصيّة، كما هــــــو الشّأن بالنّسبة إلى الحاتمــــيّ وابن وكيع التنيسيّ والعميديّ. كما وظف لتجريح جهابذة الشّعراء كأبي نوّاس وأبي تمّام وغيرهم، بهدف الحــــــدّ من شهرتهم الفنيّة والتحامل والجور عليهم. وهكـــــذا ألفينا هذا النّقد يدخل جانبا مهمّا مـــــــن التّفاعل مع التّراث الفنيّ القديم ضمن السّرقة، دون تمييز بين المحمود والمذموم في هذا الباب. بل دون “إنعام الفكر، وحسن النظر، والتحرّز من الإقدام قبل التبين والحكم إلا بعد الثّقة، (…) وقد تحمّل العصبيّة فيه العالم علـــى دفع العيان، وجحد المشاهدة، فلا يزيد على التّعرض للفضيحة والاشتهار بالجور والتحامل.”(القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصـــــومه، تحقيق وشرح محمد أبــــو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، ط4، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، 1966.
[4]– العسكري أبو هلال ، الصناعتين :الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم. منشورات المكتبة العصرية، بيروت لبنان، 1986. ص196.
[5]– لجرجاني عبد القاهر ، أسرار البلاغة، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ط1، 1991، ص 314 .
[6]– المصفار محمود، التناص بين الرؤية والإجراء في النقد القديم، مقاربة محايثة للســرقات الأدبية عند العرب، مطبعة التسفير الفني، صفاقس تونس، ط2000، ص410 .
[7]– الجرجاني عبد القاهر ، أسرار البلاغة، ص340 .
[8]– العمري محمد، البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها، منشورات أفريقيا الشرق، بيروت، لبنـــان ط1،1994 ص351 .
[9]– التنيسي ابن وكيع ،المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبـــــي ومشكل شعره، تحقيق محمد رضوان الداية، دار قتيبة للطباعة والنشر و التوزيع،1875، ص ص 340،341 .
[10]– الجرجاني عبد القاهر ، دلائل الإعجاز،تعليق محمـــــــود محمد شاكر، مطبعة المدني بجدة ط 3، .1992. ص371.
[11]– المصفار محمود ، التناص بين الرؤية والإجراء في النقد القديم، مرجع سابق، ص416.
[12]– هدارة محمد مصطفى ، مشكلة السرقات في النقد العربي، دراسة تحليلية مقارنة، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1975 ص249.
[13]– السّرقة :اسم من الفعل سَرَقَ: ف “سَرَقَ منه مالا يسرق سَرَقًا بالتحريك، والاســــــم السَّــــــرقُ والسرقةُ بكسر الـــــراء فيهما جميعا. واسترق السمع، أي استمع مستخفيا. ويقال: هو يُسارق النظر إليه، إذا اهتبل غفلته لينظر إليه. (الجوهري، الصحاح، مادة: سرق) . ويفـــــرق ابن منظور بين السّرقة وما شابهها، فيقول : السّارق عند العرب من جاء مُستَترا إلــى حرز، فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ مــن ظـاهر فهــــو مُختًلسٌ ومُستَلبٌ و مُنتَهبٌ، فإن منع مما فـــــي يديه فهــــــــــــــو غاصبٌ. (لسان العرب، مادة: سرق). بهذا يجد الباحث نفسه أمام مجموعة من المصطلحات التي ستُقَاربُ السّرقة منها: الاختـــلاس، والسّلب، والنّهب، والغصب. والملاحظ أن البلاغيّين العرب قد اهتمـــّوا اهتماما مُتباينا بموضــوع السّرقة، كما تباينت مواقفهم بشأنها، من ذلك مثلا أنّ ابن قتيبة نأى عــــن ذكر لفظ السّرقة عــــــن الشّعراء المسلمين، مُستبدلا إياها بألفاظ مثل: الأخذ، والسّلخ، والاتّباع. بينما تحدث الجرجاني مختصــرا مجملا في كتابه ” أسرار البلاغة ” عن مفهوم الأخذ (السرقة ) فـــــي إطار وضعه لنظريّته عـــن تقسيم المعاني إلى عقلية وتخييليّة، ويُعتبر كلام الجرجاني تأسيسيّا في هـــــذا الباب، مع أنّه لم يضع تعريفا ضـــــابطا للمصطلح أو غيره من المصطلحات التي أشار إليها في سياق كلامه المجمل، والتــــي منها: الاقتداء، والاستمداد، والاستعانة. والمهم هو أن ندرك، أن البلاغييّن العرب لم يتفقوا في مصطلحاتهم، ســـــوى علـــى معنى الأخذ والسّلخ، كما أنّهم افترقوا غاية الافتراق في باقي المصطلحات. على أنّ الأهـــــــم في هذا السّياق، هو التأكيد على قدم الظاهرة، أي” العلاقات النصيّة “،أو تداخل النّصـــوص ممارسة واصطلاحا، وإن اختلفت المسمّيات، وتباين النّقاد في ضبط المصطلح .
[14]– الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص،423-422.
[15]– المرجع نفسه، ص300.
[16]– ناصف مصطفى، نظرية المعنى في النقد العربي، دار الأندلس، بيروت.
[17]– الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص315.
[18]– المصفار محمود، التناص بين الرؤية والإجراء في النقد القديم كرجع سابق، ص420.
[19]– kristiva Julia: Semiotiké: Recherche pour une semanalyse, ed du Seuil 1974, p.119.