الملخّص
يحمل مفهوم “الطائفة الممتنعة” وراءه تاريخا حافلا بالتحوّلات والتقلّبات، فقد جعله الفقهاء القدامى قاعدة ثابتة في بناء “السياسة الشرعيّة”، استنادا إلى سوابق محدّدة في سيرة السّلف. وفائدة هذا المفهوم أنّه يثبّت الصلة بين العقدي والسياسي، بما يحتّمه من مفاصلة حاسمة بين المؤمنين، وغير المؤمنين. وشهد هذا المفهوم توسّعا دلاليا مهمّا عند الجهاديين المعاصرين، عبر إقرار صفة التكفير وربطها بالامتناع، وتغليظ العقوبة لأهل هذه الطائفة. وكانت غاية هذا التعديل الدّلالي، تكييف هذا المعتقد المذهبي لنصرة الأهداف المعاصرة للجماعات الجهاديّة، ذات المرجعيّة السلفيّة.
الكلمات المفاتيح: الطائفة – الامتناع – الشريعة – الجهاديون– التكفير– الإرجاء المعاصر.
Abstract
The concept of “the abstaining sect”, which has a history of transformations and volatility as ancient Muslim jurists made it an established rule in the construction of “the religious policy”, is based on the specific precedent conduct of the predecessors. This concept is characterized by a reinforcing link between the religious and the political, which entails a definitive separation between the believers and the non-believers. “The abstaining sect” has seen an important semantic expansion with the contemporary jihadists, through the establishment of “Takfir”, linking it to the abstention, and heavily penalizing it. The semantic amendment was meant to adapt this sectarian creed to the contemporary aspirations of these jihadi groups, of their Salafi background.
مقدمة:
من أبرز تجلّيات النزوع السّلفي في الفكر الإسلامي المعاصر، ذلك البروز الواسع لظاهرة إعادة إنتاج عناصر أساسيّة من الإبستيميّة القديمة، على الرغم من فواتها التاريخي. وأكثر ما تمّت العناية بإحيائه من ذاك النظام المعرفي الموروث جانب المصطلحات، والمفاهيم القديمة، اعتبارا لدورها الأساسي في تماسك بنية سائر العلوم، وفي تأسيس محاورها الكبرى. ومع ترسّخ أقدام الحركات السلفيّة، وانتشارها الواسع منذ منتصف القرن الماضي، تزايد الاهتمام بإحياء نموذج “علوم السلف”، والاحتفاء بمعارف المتقدّمين ممّن تظافرت الأخبار عن تفقّههم في الدين، وإحاطتهم بأسراره. وكان هذا الرّهان المعرفيّ، القائم على إحياء “العلوم الشرعيّة” من أولويّات الحركات السلفيّة المعاصرة، لإثبات مبرّرات وجودها الراهن، في مواجهة تحدّيات الحداثة، ونسقها المعرفي المعلمن. وفي سياق هذه المواجهة، استعاد منظّرو التيّار السلفي بلورة جملة من المفاهيم المؤسّسة لنسقهم الفكريّ. وضمن هذا السياق تمّت إعادة صياغة مفهوم “الطائفة الممتنعة”، من أجل رسم الحدود بينهم، وبين مخالفيهم المعاصرين.
واكتسب مفهوم “الطائفة الممتنعة” مكانة خاصّة عند القائلين به اليوم، بسبب علوّ صيته بينهم، كمقالة دينيّة مركزيّة، كانت لها قيمة تحليليّة معتبرة في مراحل تاريخيّة مشابهة للمرحلة الراهنة. ومدار أطروحتهم، في هذه الناحية، على أنّ هذا المفهوم يمكّن من الفصل الحاسم بين دائرة المؤمنين، ودوائر الذين يعادونهم، ويعرّف بما يستتبع هذا الفصل من التّكاليف الواجبة في حقّ المسلمين، انتصارا لعقيدتهم، وصونا لوجودهم. ويثير الاستثمار في المفاهيم الدينيّة المفوّتة جملة من الإشكاليّات المعرفيّة، والدينيّة، والحضاريّة. وهو ما يفرض مراجعة نقديّة دقيقة لتاريخ هذا المفهوم، وأطوار تقلّبه بين العصور، دونما إغفال للكشف عن الإستراتيجيات التأويليّة التي أسندته، وأسّست لوظيفته السجاليّة في المعارك الراهنة.
1- في تشكّل المفهوم
يحمل مفهوم “الطائفة الممتنعة” وراءه تاريخا حافلا بالتحوّلات والتقلّبات، التي شهد خلالها مدّا وجزرا، وتردّدا بين الظّهور والضّمور، بحسب ما كانت تؤول إليه أوضاع الاجتماع الإسلامي. واستغرق تبلور هذا المفهوم، وتطوّره مراحل متلاحقة، قد تستعصي الإحاطة بكلّ أطوارها، بسبب خفائها، وندرة الشواهد الدالّة عليها. ومن علامات هذا الظهور البطيء أنّ لفظي عبارة “الطائفة الممتنعة”، لم يجتمعا في هيئتها تلك، أي كمركبّ نعتي إلاّ بعد مدّة من تواترهما منفصلين في جملة من النّصوص، والمرويّات القديمة.
وفي لسان العرب “الطائفة من الشيء جزء منه”، وأكثر استخدام لفظ الطائفة في تعيين “الجماعة من الناس”[1]، أي مجموعات الأفراد ضمن الجماعة الكبرى. والشرط في عدد أعضاء الطائفة أن يتراوح بين الواحد والألف. وفي آيات قرآنيّة كثيرة تردّد هذا اللفظ، ليدلّ على فريق من المؤمنين[2]، أو على جماعة من المعاندين[3]. أو على فئة غير محدّدة الانتماء[4]. وجاء ذكر “الطائفة” في الحديث النبوي بصيغة تمجيديّة[5]، من دون استبعاد إمكان انقسام الطائفة المؤمنة إلى “فرق”، يكون مآل بعضها الضلال[6]. وتطوّر اللفظ لاحقا، فاستخدمه المتصوّفة للإشارة إلى فرقهم المختلفة، كما نعت به أصحاب الحرف، مع نشوء المدن الإسلاميّة[7]. وفي المباحث السوسيولوجيّة الحديثة، دلّ لفظ الطائفة على الجماعة الدينيّة ذات الاعتقاد المخالف لما هو سائد في المجتمع، وكان فيبر (Max Weber) قد أقام مقابلة تامّة بين الطائفة، والكنيسة[8]. وفي هذا الحدّ، اتّسمت الطائفة بالانغلاق، وشدّة تمسّكها بمعتقدها، مقابل الطابع الكونيّ للكنيسة، وقبولها بالتّعايش مع الآخر[9].
وفي المقابل لم يرد لفظ “امتنع”، ومشتقاتّه في القرآن، كما أهملته قواميس اللغة. واستخدمت مشتقّات صيغة الثلاثي “منع”، على نحو واسع في عدد من آيات القرآن، وفي القواميس. وغالبا ما تمحّضت دلالتها اللغويّة للإشارة إلى معنى “تحجير الشيء”، واختصّت صيغة “منَعة” منه، بإفادة معنى القوّة والعزّة[10]. وفي بعض كتب الحديث، جاء فعل “يمتنع” في باب الإكراه، للإشارة إلى معنى الإحجام، وترك الفعل[11].
ويعود أوّل ربط غير مباشر بين مفهوم “الطائفة”، بما هي جزء من الجماعة، ولفظ “منع”، و”امتنع”، بما هو إحجام وترك إلى حادثة “امتناع” بعض القبائل المسلمة عن أداء الزكاة، بعد موت النبي. وقد قاتلهم أبو بكر في أولى سنوات حكمه، بسبب هذا المنع. وكان معنى المنع بمثابة البؤرة المركزيّة للصراع بين الطرفين، فقد تداول الطرفان هذا اللفظ في سياق سجالي متّسم بالتشنّج، والعداء: سياق التهديد من جانب الخليفة[12]، وسياق المفاخرة من جانب القبائل[13]. وشكّل الموقف الحازم ضدّ مانعي للزكاة سنّة تقضي بقتال من ترك ركنا من أركان الدين. وتحوّل هذا الموقف إلى قاعدة ثابتة في الحكم على الفرق الدينيّة، التي انفردت بمذاهب دينيّة، وسياسيّة خاصّة، كالخوارج والشيعة. وألحقت بها نعوت تهجينيّة تسمها بـ “الخروج” عن الإمام، و”المروق ” عن الجماعة[14]. واحتكر الحاكم المتغلّب صفة “الإمام العادل”، وأصبغ على الخاضعين له لقب “جماعة أهل العدل”، مقابل رمى معارضيه ب “أهل الأهواء”. ونجح فقهاء السلطة المتغلّبة في إنشاء عازل رمزي بين الجماعة الكبرى، والطوائف المناوئة بذريعة امتناعها عن إقامة بعض أركان الدين، أو خروجها عن ولاية “الإمام العادل”.
2- مرحلة التقعيد
بعد حوالي ثلاثة قرون من استقرار أوضاع الحكم، تمّت صياغة القواعد الفقهيّة المبيّنة لأحكام الطوائف المخالفة لمذهب الجماعة، وسلطة إمامها، استنادا إلى ما كرّسه الواقع من سنن التعامل معها. وشرّعت قواعد “الأحكام السلطانيّة” قتال كلّ ممتنع، وميّزت بين الامتناع عن دعوة الإسلام، الذي يظهره المشركون، والامتناع عن سلطة الإمام الذي يكون من المرتدّين، أو البغاة، أو المحاربين. وغاية هذا التمييز تحديد قصديّة القتال، فالمشرك لا يقبل منه إلاّ الدخول في الإسلام، أمّا المرتدّ، والباغي، والمحارب فغاية قتالهم إرجاعهم إلى طاعة الإمام. ولكنّ المرتدّ، إذا ضمّ إلى امتناعه، جحود ركن من أركان الدين، كالزكاة أو غيرها، فإنّه يعامل معاملة المشرك. ولغير الممتنعين، من “المقدور عليهم”، من هذه الطوائف أحكام أخرى دون القتال، وإن أوجبت القتل لمن استمسك بجحود ركن، أو أكثر من أركان الدين[15]. ومدار الأحكام عند الماوردي على تعيين ما يجب في حالي الامتناع، والقدرة، مع مراعاة طبيعة الجهة الممتنعة، أو المقدور عليها. ويستوي أمام تلك القواعد المشرك، والمسلم الخارج عن الجماعة بتأويل سائغ (مانع الزكاة، والباغي)، أو من دون تأويل سائغ (المحارب). ولأجل هذا الجمع غاب في أحكام الماوردي الحديث عن الطائفة، الذي يفترض حصر القول في الجزء الخارج من الجماعة الإسلاميّة.
واستأنف ابن تيمية جهود التقعيد الفقهي لمسألة الامتناع، من دون أن يبعد كثيرا عمّا تقرّر قبله، فقد أفتى، في بعض مدّعي الإسلام كالتتار وغيرهم، بأنّ «كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام، الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم، فإنّه يجب قتالهم حتّى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين ببعض شرائعه»[16]. واجتماع الامتناع عن الشرائع بجحود وجوبها، لا يؤدّي إلى تغليظ المقاتلة فقط، كما تقرّر عند الماوردي، بل يضمّ إليه حكما آخر، عند ابن تيمية، وهو التكفير، أي الحكم بالخروج من الملّة. ويستوي في حكم تكفير الجاحد، الممتنع والمقدور عليه، غير أنّ الأوّل يقاتل، أمّا الثاني فيردّ بالحجّة، أو العقوبة. ولكنّ التحوّل الحاسم في قواعد ابن تيميّة، قد تكثّف في بلورة مفهوم “الطائفة الممتنعة”، كمقالة دينيّة شاملة، تختصّ ببيان أحكام المسلمين، أفرادا وجماعات، من أصحاب المذاهب المنسوبة إلى الضلال، والذين امتنعوا بالشوكة القاهرة من بعض الشرائع الظاهرة، أو من ولاية إمام الجماعة[17]. ولا تدخل قواعد التعامل مع المشركين ضمن أحكام “الطائفة الممتنعة”، لكونهم خارج دائرة جماعة الأمّة، ولا يصحّ، تبعا لذلك اعتبار هؤلاء من ضمن الطوائف الممتنعة.
وفي فتاوى ابن تيمية، وآرائه الكثيرة تفصيل دقيق لما يجب في حقّ هذه الطائفة، فقد بيّن أنّ قتال “الطائفة الممتنعة” يجب ابتداء، ودفعا، وهو في الحالة الأولى فرض كفاية، ولكنّه يصبح في الثانية، فرض عين. ويستوي في المآل الممتنع، والمقدور عليه، فالأوّل يقاتل ما دام على امتناعه، والثاني يقتل ما أقام على جحوده. وفي هذه القاعدة، أخذ ابن تيمية بقول الماوردي، وكان كلاهما يستلهم حزم أبي بكر في مواجهة أهل الامتناع والجحود، من مانعي الزكاة. وخلافا للماوردي الذي كان يميل إلى تفويض الحكم على الطوائف الممتنعة إلى الإمام، وسّع ابن تيمية في هذا التفويض، وجعله متردّدا بين فرض الكفاية، وفرض العين، تبعا لحالي الدفع والطلب في الجهاد. واستنادا إلى هذا التوصيف، وجد الوعي الجهادي المعاصر، مبرّرا كافيا لإدانة المجتمعات الإسلاميّة، وتكفيرها باعتبارها “طوائف ممتنعة”.
3- “الطائفة الممتنعة” في الوعي الجهادي المعاصر
توسّع الكتّاب الجهاديّون المعاصرون في تأليف مقالة “الطائفة الممتنعة”، واستحدثوا آراء تفصيليّة كثيرة، تتعدّى ما قرّره ابن تيمية، وإن ادّعوا الانتساب إليه، وإلى مذهبه السلفي. وفي تحرير هذه المقالة، اختار معظمهم التوقّف عند ناحيتين أساسيّتين: أوّلا، صفة الطائفة الممتنعة، وما تعرف به من أحوال مختلفة. وثانيا، ما يجب في حقّها من أحكام شرعيّة. ويظهر من هذه الإحاطة الواسعة علوّ مكانة هذه المسألة، في رؤية أولئك الكتّاب للوضع الإسلاميّ الرّاهن.
أ- حدّ الطائفة الممتنعة، وأحوالها
أظهر منظّرو التيّار السلفي الجهادي عناية فائقة بالضبط المفهومي، في تحرير موقفهم من موضوع “الطائفة الممتنعة”. ووضعوا حدود الألفاظ المتداولة في باب الامتناع، لبيان الفروق اللّطيفة بين المعاني المتقاربة. وحرصوا على التّمييز بين الامتناع، وما شابهه من مواقف عقديّة متعدّدة كالتّكذيب، والجحود، والإعراض، والجهل، وهي -عندهم- مظاهر لأنواع من الكفر[18].وتعدّدت وجوه التفريق بين الامتناع، وما يرجع إلى الأسباب الخفّية للكفر كالريب والشكّ، أو الإعراض، أو التولّي عن الطاعة، أو التقليد، أو الحسد والبغض، أو الاستهزاء[19].
وفي حدّ مفهوم الامتناع، ذهبت الأقوال إلى أنّه كفر إباء واستكبار، لا جحود فيه، لقيامه على «اعتقاد صدق المخبر، مع تكذيبه في الظاهر»[20]. وعدّ الامتناع عملا من أعمال الجوارح، المنافية لما وقر في القلب من قبول وتسليم. وأصله ترك الانقياد إلى الشريعة في الأعمال الظاهرة، كاستكبار إبليس عن السجود، وامتناع المرتدّين عن أداء الزكاة. ويشبّه الممتنع بالمماطل عن أداء ما عليه من دين، مع إقراره بصحّة الدين، وبنيّة إرجاعه[21]. ولكنّ هذا الحدّ ليس محلّ اتّفاق تامّ، إذ أنكر بعضهم صحّة اعتبار شرط الجحود في الامتناع، إذا أخلّ بأصل الإيمان، ونسبوا إلى ابن تيميه تأكيده أنّ قول الممتنع عن الشرائع بوجوبها، ليس سوى قول كاذب، فيكون بذلك كلّ ممتنع جاحدا، بمجرّد امتناعه[22].
وللتمييز بين الامتناع، وما شابهه من أحوال اعتقاديّة، وظيفة أساسيّة، جوهرها إظهار فضل رأي أهل السنّة، كمذهب وسط بين رأي المرجئة، الذين لا يكفّرون الممتنع إلاّ مع الجحود، وقول الخوارج الذين يكفّرون المتهاون. ويقضي مذهب أهل السنّة، في المنظور السلفي بتكفير الجاحد والممتنع، دون المتهاون. وأدخل، بعضهم ضمن دائرة الكفر صنفا رابعا، سمّوه: “التارك”، وهو المعرض عن الشريعة، من دون إقرار أو إنكار، وإن كان متكلّما بالإسلام[23].
وللامتناع أحوال متعدّدة، تختلف بحس بدرجة الإباء والعناد، أو باعتبار الجهة الممتنعة. أمّا من جهة الدرجة، فيكون الامتناع كلّيا، إذا شمل الإعراض عن الشريعة كلّها، ويكون جزئيا، إذا اقتصر الترك على بعض الأركان. واعتبر الامتناع أشدّ من المنع، لارتباطه بالعناد والإباء. وأمّا من جهة الممتنعين، فقد يحصل الامتناع من الشخص المنفرد، كما يكون من الجماعة، ذات الشوكة. وخلافا لبعض آراء المتقدّمين، فقد رأى الجهاديّون أنّ الامتناع قد يكون أصليّا، إذا كان من المشركين الذين لم يسبق لهم دخول الإسلام. ويكون امتناعَ ردّة، إذا كان من الرّاجعين عن الإسلام. والملاحظ أنّ هذا التصنيف الأخير، على أهمّيته، ينطوي على نقض جزئي لما استقام عليه تعريف “الطائفة الممتنعة”، الذي لا يحتمل معنى امتناع المشركين[24]. ومن التصنيف ما يستند إلى الجهة الممتنع عنها، فيكون الامتناع عن الشريعة، أو عن قدرة السلطان. وهذا الامتناع الثاني له وجهان: إمّا امتناع بالسلاح والأعوان، أو بالفرار إلى دار الكفر، والتحصّن بها[25].ولا تلازم بين الامتناع عن الشريعة، والامتناع عن القدرة، فالأخير يشمل الأوّل، فليس كلّ ممتنع عن الشرع ممتنع عن القدرة، غير أنّ كلّ ممتنع عن القدرة هو ممتنع عن الشرع حتما[26]. وأمّا المقدور عليه فهو الممتنع عن الشريعة، غير أنّه واقع ضمن قدرة السلطان.
وهذه الاستفاضة الواسعة في وصف “الطائفة الممتنعة”، وما يعرض لها من أحوال مختلفة، كانت تمهّد لعرض قرائن الامتناع، والعلامات الدالّة عليه، قبل بيان الأحكام الخاصّة بكلّ حالة، في المنظور السلفيّ الجهادي.
ب- قرائن الامتناع وأحكامه
لاستكمال ملامح مقالة “الطائفة الممتنعة”، وربطها بمجريات الواقع في مختلف الأزمنة، سعى منظّرو التيّار الجهادي إلى تحديد أشكال تجلّيها، وبيان القرائن الدالّة على قيام حالة الامتناع، وعدم الانقياد للشريعة. واقتفوا آثار أسلافهم، في مرحلة أولى، فذكروا من علامات الامتناع قتال المسلمين، والاستباحة العمليّة للأحكام الشرعيّة، وترك التكاليف الواجبة، والطعن في ثوابت الاعتقاد[27]. وأكّدوا أنّه لا يؤاخذ في الامتناع إلاّ بالأسباب الظاهرة، أيبقول مكفّر، أو بفعل مكفّر. وأمّا الكفر بالاعتقاد الباطن فلا يدخل في الامتناع، بدليل قول النبي (أفلا شققت عن قلبه)[28]. ومدار التمثيل للامتناع في مدوّنة الجهاديين، على ثلاث حالات: امتناع إبليس عن السّجود، وعدم أداء بعض القبائل للزكاة، ونكاح امرأة الأب.
واستنادا على هذه الأمثلة، عمد الجهاديّون، في مرحلة ثانية، إلى وضع تطبيقات كثيرة على الأوضاع المعاصرة. وجعلوا أكثر كلامهم في تشخيص الأوضاع الراهنة، على مقتضى تقديرهم لمخاطر وجود “الطائفة الممتنعة”. وأبرز صور الامتناع المعاصرة، عندهم، هو “العمل بغير ما أنزل الله”، في المجتمعات الإسلاميّة. ولهذا الامتناع وجهان بارزان: الاحتكام إلى القوانين الوضعيّة، والخضوع إلى سلطة حكّام “مرتدّين”، لهم حكم” الطاغوت”[29]. وعند الجهاديّين المتأخّرين، اتّسع مفهوم الطاغوت، وأُخرج عن حدود ما رسمه سيّد قطب، إذ أقحمت، ضمن دائرته فئات واسعة ممّن سمّوا “أعوان الحكّام”، أو “أعوان الظالمين”. وتتألّف طائفة الأعوان من فريقين: مناصرون بالأقوال، وهم “علماء السوء”، والكتّاب والصحافيّون، ومناصرون بالأفعال، كالجنود ورجال الشرطة[30]. ويدخل ضمن هؤلاء كلّ من كانت له أيّ مصلحة، أو أدنى معاملة مع السلطة وأعوانها[31]. ومن هذه الأطراف يتألّف، في الوعي الجهادي، كيان “الطائفة الممتنعة”، في صورتها الرّاهنة.
ويشفّ هذا التصوّر عن ازدياد منسوب الغلوّ، والارتياب في سائر المخالفين لمذهب الجهاديين. والأكثر إثارة أنّ هذا التصوّر الانعزالي ينسف جانبا مهمّا من تصوّر القدامى لهذه المسألة، فـ “الطائفة الممتنعة” في هيئتها الأصليّة تشكّل جزءا من الأمّة، ولكنّها خرجت عنها بتأويل سائغ، أو غير سائغ. أمّا الطائفة عند المعاصرين فتضمّ أكثر الأمّة، وهم المرتبطون بالدول القائمة، ولا يخرج منهم سوى جماعات الجهاديين. وبهذا الانقلاب الذي صار به الامتناع غالبا، بل هو مذهب “الأمّة/ الجماعة”، أصبح “الحقّ”، و”العدل”، منحصرا في “طائفة” مستضعفة من المؤمنين، اختار لها دعاتها اسم “الطائفة المنصورة”، في مقابل “الطائفة المدحورة”، أو “الممتنعة”. ولاستنهاض عزائم الأنصار، عمل الدّعاة على ترجيح الكفّة لصالح طائفتهم “المنصورة”، بادّعاء توفّرها على قوّة لا تغلب، تجعلها غير قابلة للزّوال، لأنّها موعودة بالنّصر الإلهيّ، وهي المفوّضة بإقامة الجماعة الكبرى المؤمنة، أو دولة الإسلام[32].
وغاية الكلام على “الطائفة الممتنعة”، بعد حدّها، والتمثيل لها ببعض تجلّياتها القديمة، والمعاصرة، إظهار الأحكام “الشرعيّة” الواجبة في حقّ أتباعها. ولا خلاف بين الجهاديّين، على أنّه يجب في حقّ “الطائفة الممتنعة” حكمان اثنان: التّكفير، والقتال. ولهذه القاعدة استثناء من وجهين: يُستثنى من حكم القتال المُعاهد، والذي لم تبلغه دعوة الإسلام، ويبقى لهما حكم التّكفير. وفي المقابل لا يكفّر الباغي، غير أنّه يقاتل ما أقام على امتناعه، ولا يسقط عنه القتال إلاّ بدخوله تحت القدرة، وخضوعه لولاية السلطان[33]. ولا يخفى ما في هذه الأحكام الفرعيّة، الخاصّة بالمعاهد، والباغي من ذهول عن الواقع الراهن، الذي يخلو من هذه الأصناف. وليس في المدوّنة الجهاديّة أدنى إشارة إلى البغاة، والمعاهدين المعاصرين.
وقتال الممتنع لم يكن محلّ تبرير في المدوّنة الجهاديّة، خلافا للحكم بتكفيره. والأرجح أنّ ترك الاحتجاج للحكم الأوّل عائد إلى اتّساع دائرة الإجماع حوله (الماوردي، وابن تيمية، وقبلهما البخاري[34]). أمّا حكم التّكفير فقد كان موضوع مجادلات مستفيضة، وغالبا ما نصّب المرجئة طرفا خصما، لاشتراطهم في حكم التّكفير جحود الشّرائع. وفي أثناء هذه المجادلة كان ينسب إلى “الإرجاء المعاصر” كلّ معارض، أو متردّد بشأن تكفير الممتنع. وللبراءة من تهمّة الغلوّ في التكفير، دأب الجهاديّون على استحضار الموقف الخارجي المكفّر لأصحاب المعاصي، ليفاخروا بـ “وسطيّتهم”، التي تجسّدها قاعدة:(لا نكفّر مسلما بذنب ما لم يستحلّه)[35].وأكثر ما كان يحذره الخطاب الجهادي موقف التساهل “الإرجائي”، لأنّه «بمثل هذه الخرافات أصبح الحاكم الكافر مسلما، معصوم الدم»[36]. ولا يكتفي الجهاديّون بتكفير الكافر، بل يقرّون وجوب تكفير من لا يكفّر الكافر، وهو ما يوسّع من دائرة الكفر، ليشمل السواد الأعظم من المسلمين.
والتمسّك بحكم التّكفير، يجلوه إصرار، بعض الكتّاب الجهاديين، على تكفير “الطائفة الممتنعة”، من دون تمييز بين رأس الطائفة، وبين أعوانه وأتباعه. ويحيل هذا الموقف على سجال داخلي بين جماعات الجهاديين، على خلفيّة توقّف بعضهم عن تكفير هذه الطائفة، إلاّ بعد تبيّن أحوال أفرادها على التعيين. وميّزوا في أحوال الناس بين نوعين من الموالاة للحاكم: ظاهريّة، وباطنيّة، وعدّوا الأولى معصية، والثانية كفرا[37].وفي نقض هذا الموقف “المتساهل”، ذهب آخرون إلى أنّ «الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين عن القدرة»، لأنّ الله سوّى بين التابع والمتبوع في الحكم[38].وفي أعمال الجوارح تكفي المتابعة في الأقوال والأعمال، من دون اشتراط الموافقة في الاعتقاد[39]. وسدّا لأبواب التماس الأعذار لأفراد “الطائفة الممتنعة”، جعل بعض كلّ الوزر، في بقاء الامتناع، لأنّهم اليد القاهرة التي يبطش بها الحكّام “الطواغيت”[40].
والحكم بتكفير “الطائفة الممتنعة”، تترتّب عنه قواعد كثيرة منها، أنّ الممتنع لا يُصلّى عليه، ولا يورّث، وتجب البراءة منه[41]. وأخطر ما ألحّ عليه الجهاديّون إباحةُ دمه، وماله لكلّ متمكّن منه، فـ «من كان ممتنعا بشوكة، أو بدار حرب جاز لكلّ أحد قتله، وأخذ ماله بغير استتابة»[42].وهذا الموقف المخالف لأقوال السلف، مردّه إلى تسليم الجهاديين المعاصرين بخلوّ الزمان الراهن من الإمام العادل، الذي أناط به الفقه القديم إقامة الحدود، وحمل لواء الجهاد. وكان من تبعات تحرير المبادرة بالقتل، اتّساع دائرة الحرب على المجتمع، بمختلف الوسائل المتاحة من المعارك شبه المنظّمة، إلى العملّيات “الانغماسيّة” التي يقدم عليها الأفراد. وتكفّلت قواعد “فقه الدماء” التي وضعها الجهاديّون ببيان تفاصيل كثيرة في صفات القتل “الشرعي”، لكلّ الداخلين ضمن “الطائفة الممتنعة”[43].
لقد ارتبط ظهور فكرة “الطائفة الممتنعة” بتشكّل “الجماعة” الباحثة عن الإجماع على شرعيّتها. والوسم بالامتناع من تدبير السّلطة السياسيّة والدينيّة المتغلّبة، لأجل تهميش خصومها وإلغائهم. وتعلّقت الأرتودوكسيّة الدينيّة بهذه الفكرة للاحتماء بها ضدّ موجات التّشكيك في العقائد، والتّهاون في شأن التعاليم الدينيّة. وعبر المراحل التاريخيّة المتلاحقة، ظلّ التلازم قائما بين انتعاش فكرة “الطائفة الممتنعة”، ولحظات التأزّم الاجتماعي والحضاري، المقترن بالعجز عن الإصلاح، والتقدّم، كما حصل في عهد غزو التتار لديار المسلمين، أو كما هو حاصل في المرحلة الراهنة التي تشهد تأخّر المسلمين، وعدم قدرتهم على النهوض، والتقدّم. وليس استعداء الفئات الاجتماعيّة المخالفة، أو الناشزة سوى تعبير عن حالة من العجز المجتمعي العامّ عن معالجة الأسباب الداعية إلى ذلك النشوز. أمّا المباينة الناشئة عن الخصوصيّات الدينيّة والفكريّة، فلا تستوجب سوى التدرّب على استيعاب المخالف، وفتح مسالك الحوار الدائم معه.
[1]– ابن منظور، لسان العرب، مادة [طوف].
[2]– ﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ﴾ آل عمران:154. وانظر كذلك: النساء: 102، التوبة: 122، النور: 2.
[3]– ﴿وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ﴾ آل عمران: 67. وانظر كذلك: النساء: 81، 113، الأنعام: 156، التوبة: 83، الأعراف: 87، الأحزاب: 13.
[4]– ﴿إنّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ القصص: 4.
[5]– (لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ، لا يضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك)، أ. ي. فنسنك، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، مكتبة بريل، 1936، ج 4، ص 53.
[6]– (لتنزلنّ طائفة من أمّتي أرضا يقال لها البصرة، ويكثر بها عددهم، ونخلهم، ثمّ تجيء بنو قنطوراء، عراض الوجوه، صغار العيون، حتّى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة، فيتفرّق المسلمون ثلاث فرق: أمّا فرقة فيأخذون بأذناب الإبل، فتلحق بالبادية، فهلكت. وأمّا فرقة فتأخذ على أنفسها وكفرت، فهذه وتلك سواء. وأمّا فرقة فيجعلون عيالاتهم خلف ظهورهم ويقاتلون، فقتلاهم شهيد، ويفتح الله عزّ وجلّ على بقيّتهم)، المرجع السابق، ج 4، ص 53.
[7]– عزمي بشارة، الطائفة والطائفية: من اللفظ ودلالاته المتبدّلة إلى المصطلح السوسيولوجي التحليلي، مجلّة عمران، العدد 23/ 6، شتاء 2018، ص 13.
[8]– انظر: Max Weber, economy and society, an outline of interpretive sociology, edited by Guenther Roth and Claus Wittich, University of California Press, Berkeley. Los Angeles. London, 1978, p: 1204, 1205.
[9]– انظر: Hourmant Louis, Notions d’église et secte, Encyclopédia Universalis: https://t.ly/ACtH
[10]– في الحديث (سيعوذ بهذا البيت قوم ليس لهم منعة).
[11]– (فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله، والمكره لا يكون إلاّ مستضعفا، غير ممتنع من فعل ما أمر به)، صحيح البخاري، الدار المتوسّطيّة للنشر، تونس، ط 1، 1426ﮬ/ 2005م، كتاب الإكراه، ج 4، ص:225-226.
[12]– ينسب إلى أبي بكر قوله: “والله لو منعوني عناقا وعقالا ممّا أعطوه لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم لقاتلتهم عليه”، الماوردي، الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة، تحقيق أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة الكويت، 1409/ 1989، ط 1، ص 78.
[13]– روي في هذا الباب شعر لأحدهم، جاء في بعضه ما يلي:
أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر
فإنّ الذي سألولكم فمنعتم ولك التمر أو أحلى إليهم من التمر
سنمنعكم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة اليسر
انظر: الماوردي، الأحكام السلطانيّة، مصدر سابق، ص 78.
[14]– الشهرستاني، الملل والنحل، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، ط 2، 1413ﮬ/ 1992م، ص 107.
[15]– الماوردي، الأحكام السلطانيّة، مصدر سابق، ص 49 وما بعدها.
[16]– ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، كتاب الجهاد، ج 28، ص 223.
[17]– المصدر السابق، ص 358 وما بعدها.
[18]– أبو علي المرضي، حقيقة كفر الامتناع وحكم الطائفة الممتنعة عن الشريعة.
[19]– عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع في طلب العلم الشريف، منبر التوحيد والجهاد، د ت، ص 428.
[20]– المصدر السابق، ص 426.
[21]– المرضي، حقيقة كفر الامتناع، مصدر سابق.
[22]– عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع، مصدر سابق، ص 580. واحتجّ كذلك برأي أحد الشيوخ الوهّابيين، وهو محمّد بن إبراهيم آل الشيخ، في قوله: «لو قال من حكّم القانون: أنا أعتقد أنه باطل، فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل»، المصدر السابق، ص 580-581.
[23]– المرضي، حقيقة كفر الامتناع، مصدر سابق.
[24]– هذا التوصيف يخرج عن حدود الدائرة التي رسمها ابن تيمية للطائفة الممتنعة، والتي أقرّها الجهاديّون المعاصرون، والقاضي بأنّ الممتنع مقرّ في الباطن، ولكنّه يظهر ترك الشرائع. ومن ثمّ، فلا معنى لإدراج الامتناع الأصلي، الذي يكون من المشركين ضمن أصناف الامتناع، إذ الكافر منكر للشرائع ظاهرا وباطنا.
[25]– عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع، مصدر سابق، 492.
[26] – المصدر السابق، ص 610.
[27] – المرضي، حقيقة كفر الامتناع، مصدر سابق.
[28] -عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع، مصدر سابق، ص 426.
[29]– يعود وصف الحكّام المعاصرين بالطواغيت إلى سيّد قطب، وكان قد أخذه بدوره عن أبي الأعلى المودودي. انظر: سيّد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط 32، ج 5، ص 694.
[30] – عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع، مصدر سابق، ص 593.
[31] – المرجع عندهم في ذلك قول ابن تيمية: «وقد قال غير واحد من السلف أعوان الظالمين من أعانهم ولو أنّهم لاق لهم دواة أو برى لهم قلما، ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابه من أعوانهم»، مجموع الفتاوى، مصدر سابق، كتاب الإيمان، ج 7، ص 47.
[32] – أبو قتادة، الجهاد والاجتهاد، تأمّلات في المنهج، ص 25. انظر الموقع الالكتروني: https://bit.ly/3p6Hmqg
[33] – المرضي، حقيقة كفر الامتناع، مصدر سابق.
[34]– البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل من أبى الفرائض، وما نسبوا من الردّة، ج 4، ص 222.
[35] – عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع، مصدر سابق، ص 424. وقد نقض الكاتب آراء جهاديين آخرين في نفس السياق، على غرار عصام دربالة، وعاصم عبد الماجد، صاحبي كتاب: القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع
[36] – المقصود بالخرافات، ما احتجّ به بعض العلماء، في حادثة اغتيال السادات، بخصوص عدم جواز تكفيره لأنّه لم يكن جاحدا للشرائع. انظر: المصدر السابق، ص 581.
[37] – طلعت فؤاد قاسم، الرسالة الليمانيّة في الموالاة. انظر العنوان الالكتروني: https://t.ly/Co7d
[38] – احتجّوا بآيات منها: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ القصص: 8.
[39] – عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع، مصدر سابق، ص 611.
[40] – أبوبكر محمد بن ابراهيم الحسني، هداية الساري في حكم استهداف الطوارئ، ردّة.. وكتائب الحرمين لها، منبر التوحيد والجهاد، ص الالكتروني: https://t.ly/Co7d 2، 3.
[41] – أبو محمّد المقدسي، ملّة إبراهيم، ودعوة الأنبياء المرسلين وأساليب الطغاة في تمييعها وصرف الدعاة عنها، منبر التوحيد والجهاد، د ت، ص 1.: https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/
[42] – عبد القادر بن عبد العزيز، الجامع، مصدر سابق، ص 492.
[43] – أبو عبد الله المهاجر، مسائل من فقه الدماء، 1425ﮬ، ص 166. https://is.gd/wicQNq
المصادر والمراجع
- البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري، الدار المتوسّطيّة للنشر، تونس، ط 1، 1426ﮬ/ 2005م، كتاب الإكراه.
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، كتاب الجهاد.
- الحسني، أبو بكر محمد بن إبراهيم، هداية الساري في حكم استهداف الطوارئ، ردّة.. وكتائب الحرمين لها، منبر التوحيد والجهاد.
- الشهرستاني، محمّد بن عبد الكريم، الملل والنحل، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، ط 2، 1413ﮬ/ 1992م.
- ابن عبد العزيز، عبد القادر، الجامع في طلب العلم الشريف، منبر التوحيد والجهاد، د ت.
- الفلسطيني، أبو قتادة، الجهاد والاجتهاد، تأمّلات في المنهج. انظر الموقع الالكتروني: https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/
- فنسنك، أ. ي، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، مكتبة بريل، 1936.
- قاسم، طلعت فؤاد، الرسالة الليمانيّة في الموالاة. انظر العنوان الالكتروني: http://www.eigportal.com/index.php/
- قطب، سيّد، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط 32.
- المرضي، أبو علي، حقيقة كفر الامتناع وحكم الطائفة الممتنعة عن الشريعة. انظر العنوان الالكتروني:
- المقدسي، أبو محمّد، ملّة إبراهيم، ودعوة الأنبياء المرسلين وأساليب الطغاة في تمييعها وصرف الدعاة عنها، منبر التوحيد والجهاد، د ت. ttps://bit.ly/34rw73M
- ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب، مادة [طوف].
- المهاجر، أبو عبد الله، مسائل من فقه الدماء، 1425ﮬ. https://archive.org/details/ozaaloza_gmail_20131108/page/n10
- الماوردي، علي بن محمّد، الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة، تحقيق أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة الكويت، 1409/ 1989، ط 1.
- الدوريّات
- بشارة، عزمي، الطائفة والطائفية: من اللفظ ودلالاته المتبدّلة إلى المصطلح السوسيولوجي التحليلي، مجلّة عمران، العدد 23/ 6، شتاء 2018.
المراجع باللسان الأجنبي
- –Hourmant, Louis, Notions d’église et secte, Encyclopédia Universalis
- https://www.universalis.fr/encyclopedie/eglise-et-secte-notion-d/
- Weber, Max, economy and society, an outline of interpretive sociology, edited by Guenther Roth and Claus Wittich, University of California Press, Berkeley. Los Angeles. London, 1978.

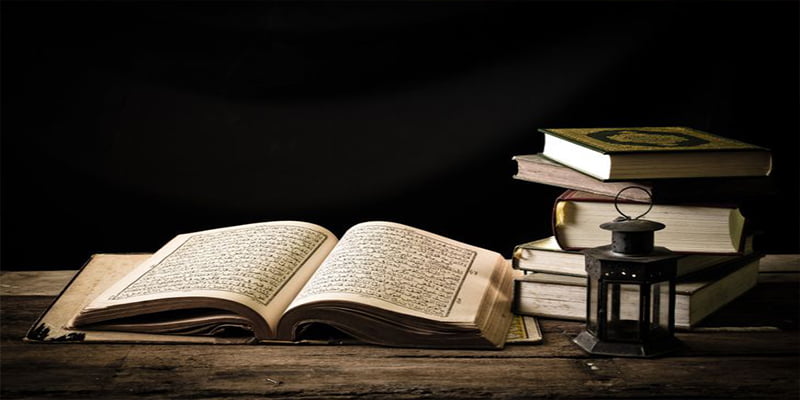
1 تعليق
الطائفة والتي هي بمعنى جماعة من الناس قد أخذت منحى آخر وفي ديينا أن هذه الأمة ستفترق على أكثر من فرقة المقصود بالفرقة هي الطائفة فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: هي الجماعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وذكر بعض أهل العلم أن المراد بالأمة فيه أمة الدعوة لا أمة الإجابة يعني أن الأمة التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله والإقرار بوحدانيته هي المفترقة إلى تلك الفرق، وأن أمة الإجابة هي الفرقة الناجية يريد بها من آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.